الأساليب الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
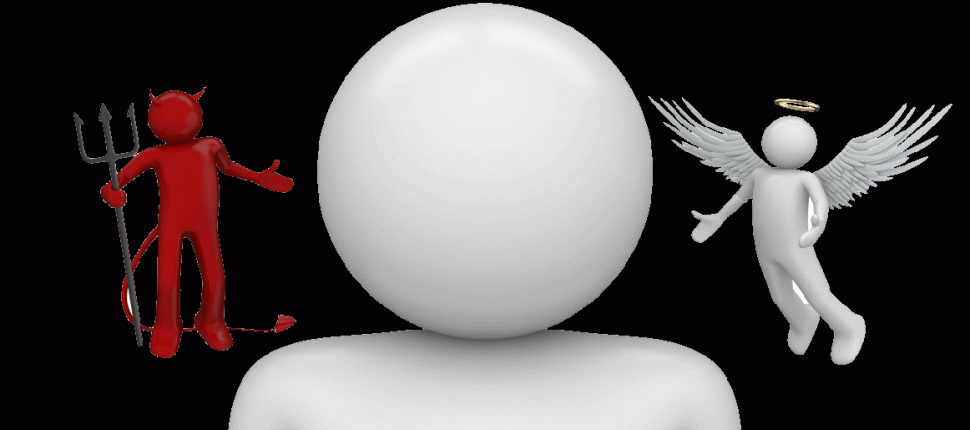
ذكرنا فيما سبق أن للإنسان تربية إلهية المدار فإذ ما أراد الوصول إلى الكمال فليس أمامه من وسيلة إلى اتباع القوانين الإلهية والارتباط بالله. وإذا ما قطعت المجتمعات الإلهية روابطها عن ذات الله الأقدس لم يعد بإمكانها الوصول إلى الكمال.
*الحاجات النفسية للإنسان
توصل علماء النفس إلى حقيقة مفادها أن للإنسان أربع حاجات أصلية من الناحية الروحية النفسية وهي في ذات وفطرة كل البشر، وهذا الحاجات هي:
* حس البحث
الإنسان موجود باحث يحب أن يطلع على كل المجهولات. ذات الإنسان تقتضي هذا الأمر.
* حس الاستقامة
طبع الإنسان يطلب الحسنات. لقد تمكن الباحثون الذين كانوا يقومون بأبحاث حول القبائل الإفريقية البدوية في إثبات وجود المسائل الأخلاقية لديهم من عفة، استقامة، صدق وغيرها. وإن لهذه الأمور اعتبار لديهم.
صحيح أنه يقال أن أول كتاب أخلاقي يعود لسقراط، لكن البشر كانوا بحاجة للأخلاق منذ اللحظات الأولى لبدء حياتهم، بل ويقال أنه لم يظهر شخص حتى الآن يرضى بعدم العفة، والذين يقومون بأعمال منافية للعفة فهذا يعود لأنهم يعتبرون أن لأفعالهم حسن ولو ثبت لهؤلاء أن هذه المسألة مخالفة للحسن أو مضادة له لما اتبعوها أبداً.
* حس الإحسان
يرغب الإنسان أن يكون حسناً، فالرغبة بالإحسان أمر مدفون في ذات الإنسان.
* حس البحث عن الله
الإنسان في صميم ذاته، باحث عن الله، نفس الإنسان خلقت بطريقة لا تستطيع أن تحيا معها منفصلة عن الله، وهذا أمر توصل إليه علماء النفس. وهنا نشير إلى بعضهم. يقول "يونك" Yong أحد عملاء النفس المعروفين في العالم، وقد كان مساعداً لفرويد ثم انفصل عنه، يقول:" الانفصال عن الله يؤدي إلى زعزعة فطرة الإنسان". ويحدثنا عالم آخر اسمه "شوبن هاور" فيقول: "كلما نمت الفيزياء أكثر، زادت حاجة الإنسان إلى ما وراء الطبيعة أكثر". ولأحد علماء إيران الكبار وهو الدكتور مهدي جلالي رأي يقول فيه: "يعتبر كل علماء النفس الإنسانية والحيوانية في سائر أنحاء العالم، أن الوسيلة الوحيدة لعلاج الاضطراب الذي يعيشه إنسان هذا العصر، هو بإعادته إلى العقيدة وتوجيهه نحو الماورائيات". وهنا نفهم معنى
﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ حيث يتضح لنا المقصود من هذه العبارة بعد أربعة عشر قرناً. لذا لا يشك علماء النفس والبيئة أن الإنسان موجود ذو معايير أخلاقية ويجب أن يرتبط بما وراء الطبيعة حتى يُسمى إنساناً.
يعلمنا هؤلاء العلماء أن ما يطرحه الإسلام والقرآن باسم الفضائل الأخلاقية ويطرحها على أنها الفيتامينات والعوامل المطورة للروح، فإن طبيعة كل البشر وفطرتهم تقتضيها. وليست أموراً جعلية. لو دققنا في تاريخ البشر بصورة جيدة لوجدناهم جميعاً يبحثون عن الاستقامة والله والقداسة، هذا بالرغم من تعدد المذاهب والطوائف التي ينتمون إليها. ما نجده في المجتمعات البشرية في عبادة للبقر، للصنم، وغير ذلك وإن كان مرفوضاً بحسب نظر الإسلام ويعتبر شركاً، لكنه تجلي لتلك الحاجات النفسية بعبادة الله والبحث عنه، ولكنه ظهر بطريقة منحرفة، وبهذا يتضح لنا كون الإنسان دائماً وأبداً يسعى خلف شيء مقدس. ولكن ولأنه لم يتعرف إلى الطريق الصحيح ضل وانحرف. إذن، ذات الإنسان تطلب الفضائل والمعارف. ولا وجود لطريق تْدخل إلى المنكر، وهذا هو الارتباط بالله. لهذا يقول علماء الغرب المتخصصون في أمور التربية في عصرنا الحاضر: ابتعاد الإنسان عن المعايير والفضائل الأخلاقية والله وما وراء الطبيعة، جعله أجنبياً عن ذاته ولا سبيل أمامه إذا ما أراد أن يعود لذاته إلا أن يتوجه نحو الله والعقيدة.
* نسيان الله
يقول القرآن فيما يخص هذا الأمر: ﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون﴾. يقال أن الفسق مثل فقدان التمر لغلافه الخارجي. فلو فصلنا الجوزة التي لم تينع بصورة كاملة عن قشرتها. فسيتوقف نموها. وهذا هو حال الإنسان الذي يبتعد عن الله فيكون بذلك قد فقد غلافه الذي يحصنه وبهذا يصبح أجنبياً عن ذاته. يقول الله تعالى:
﴿حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق﴾. تعتبر هذه الآية أن انفصال الإنسان عن ربه يزلزله ويجعله في معرض السقوط... وهذا هو الإنسان المتحلل من كل قيد، يبقى مضطرب الخاطر محروماً من الاطمئنان، وهذه هي الفاجعة التي شملت حال بشر دنيانا اليوم. وهنا نلفت إلى أمر لطيف ودقيق يرتبط بهذا الأمر وهو موجود في سورة الشمس، حيث يقسم الله تعالى في هذه السورة أحد عشر قسماً وبعد ذلك يقول:
﴿ونفس وما سواها،فألهمها فجورها وتقواها﴾.
يقول الله تعالى هنا، ألهم الإنسان معرفتين حتى يتعرف إلى التقوى وحتى يتعرف إلى الفجور أيضاً. التقوى هي الطيبات والفضائل الدافعة الموصلة للتكامل، والفجور هو الخبائث، أي الرذائل والعوامل الرادعة المانعة عن النمو والتكامل. وبعد ذلك يقول تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها﴾. التزكية تعني نمو الإنسان وسيره نحو الطهارة. وكلمة "دسىّ" في الآية المذكورة من مادة "دَسَسَ" أي خدع وغش، وال "ها" تعود للنفس أيضاً.
ما هو السبب الذي جعل "التدسيس" لا يصلون إلى الهدف. التدسيس يعني الغش وهو خلط الجنس الحسن بالجنس السيء وبيعه على أنه جنس حسن. مثلاً لو خلط شخص المسن النباتي بالسمن الحيواني وباعه على أنه حيواني، قيل له "أهل تدسيس". ولو كان للسمن الحيواني لسان لصاح وقال: لا تخلطني مع السمن فطبعي لا يقبل به. نجد أن القرآن استعمل الألفاظ بشكل جميل مخاطباً الإنسان: إذا دَسَسَت مع نفسك فلن تصل إلى هدفك، فطرة الإنسان طاهرة ولا تقبل المعصية ولا المنكر والخبائث، الإنسان هو من يفرض هذه الأمور على نفسه. فطرة الإنسان تقتضي البحث عن الله، الصدق، الاستقامة، العبادة، العفة، الوفاء بالعهد وغير ذلك. وإذا ما أعطيت شيئاً آخر يكون ذلك مفروضاً عليها. ولهذا يقال البحث عن الله والاعتناء بالقيم يشكل قسماً في فطرة الإنسان. ينقل أحد الخطباء قصة ترتبط بهذا المعنى يقول: اتفقت مجموعة على سرقة شيء ما، بعد أن قصدوا المكان وأنجزوا العملية أخذوا الأموال المسروقة وقرروا وضعها أمانة لدى أحد الأشخاص، وذلك حتى تحين الفرصة المناسبة ليقسموا الأموال فيما بينهم. ولكن وبسبب قلة الثقة فيما بينهم أعرضوا عن الأمر، وبعد أخذ ورد اتفقوا على وضع الأموال عند شخص موثوق متدين معروف منهم جميعاً... كما ترون السارق لا يثق بالسارق الآخر وهذه مسألة فطرية. حتى غير العفيف عندما يقرر الزواج فإنه يبحث عن زوجة عفيفة صاحبة حياء، أو إذا ما أراد إرسال زوجته أو ابنته إلى مكان فإنه لا يرسلهما مع عديمي الثقة، إلا أن يكون قد فقد إنسانيته تماماً.
هذه هي فطرة البشر، حيث أن النظام الاجتماعي والأخلاقي للإنسان لا يقبل السيئات، ولهذا يقول تعالى:
﴿... ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾.
الطيبات هي العوامل المطورة المساعدة على التكامل، والخبائث هي العوامل المانعة التي تمنع الإنسان من ذلك. وما يطرح على أنه حرام ليس أمراً جعلياً. بل فطرة الإنسان لا تقبله، وإذا فرض على الفطرة، تزلزلت وسقطت شخصية الإنسان وزالت الإنسانية. لهذا فتربية الإنسان لا تخرج عن الإطار الإلهي، وقد وصل العلماء إلى هذه النتيجة، يوجد لدى علماء النفس أبحاث لافتة حول الإنسان والمذهب وما وراء الطبيعة، يقولون: لا يمكن للإنسان أن يحيا بدون فضيلة، ولهذا يقال لا يُقبل العمل غير الخالص من الله، لأن كل عمل لا يكون لله لا يؤدي إلى التكامل، يجب أن يوضح هذا الأمر للمجتمع...
هنا لا نتحدث عن الإسلام فقط، يجب أن نوضح هذا حتى للذين لم يلتزموا بالإسلام يجب أن نقول لهم أن القوانين التي راجت في الثقافة الأوروبية قد فرضت على المجتمع بسبب انحرافه. ويعترف علماء الأخلاق في تلك الديار بهذا الانحطاط، يعني أنه لو رجعنا إلى الكتب التي ألفها العلماء الغربيون حول العلوم الإنسانية خصوصاً في القرن التاسع عشر وما بعد مثل كتب الكسيس كارل، سامئيل سمايلز، ماكس بلانك وغيرهم، لوجدنا أن كل كلامهم يحذر من العاقبة السيئة وأن نتيجة ما يقوم به الشبان، والشابات في أوروبا لن تكون إلا السقوط. لهذا يجب تعليم المعايير الأخلاقية للشبان وأن يفهموا أن طبيعة الإنسان تطلبها. لم يدع أي عالم أو مفكر أن التحرر من القيود والحدود عامل مطور للشخصية. هل يمكننا أن نجد شخصاً عاقلاً يقول: الرذائل الأخلاقية باعث لتجلي الشخصية الإنسانية؟ لهذا السبب يتفق كل العلماء والمفكرين والباحثين على أن العيش دون فضيلة يدفع بالمجتمع نحو السقوط. ولكن قامت الثقافة الغربية الاستعمارية بفرض هذه المفاسد على الإنسان حتى تنحط شخصية البشر. يجب أن يكون الإنسان مرتبطاً بالله والقوانين الإلهية، وهذا الارتباط يعني قبول أوامر الله وإطاعته فيها والابتعاد عن ما نهى عنه، إذا لم يستقم هذا الأمر في المجتمع ولم نعتن بأوامر الله سنتضرر ونخسر.
* ما هو الخسران؟
يوجد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تتحدث عن خسران الإنسان وسنبدأ أولاً ببحث معنى الخسارة ثم نشير للآيات التي تتحدث عن الموضوع. الخسارة تعني الضرر وزوال أصل رأس المال ولا تعني عدم المنفعة، لأنه يوجد فرق بين الأمرين، ففي الخسارة يخسر الإنسان من أصل رأس ماله إضافة لكونه لم ينتفع، أما في عدم الربح فالأمر مختلف. والآن نشير لبضعة آيات حول هذا الموضوع:
﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾.
هنا يبين الله للإنسان إنه إذا قام بأعمال أخرى غير العمل الصالح والالتزام بالأوامر الإلهية فسيخسر. ويقول في مكان آخر: ﴿... ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً﴾. ويقول في آية ثالثة:
﴿... والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون﴾. لهذا قام الإسلام بتعريف الفضائل للإنسان وشجعه على القيام بها، ثم عدد له الرذائل وحذره من مقاربتها. مثلاً يوجد في الإسلام شرح مفصل لمنافع الصدقة، العبادة، الحجاب ومضار القمار، الشراب، عدم الحجاب... ومن خلال تبويب المطالب التي ذُكرت يمكننا أن نعرّف المعصية بهذه الطريقة: المعصية تعني انحراف الإنسان عن قوانينه التكاملية. إذا ارتكب الإنسان المعصية زالت الإنسانية عنه ولم يعد بإمكان شخصيته أن تنمو، لأن المعصية والسيئات أعمال لا تطلبها ذات الإنسان وفطرته.
* لماذا تجب محاربة المنكرات؟
الآن وبعد أن اتضح لنا أنه يوجد لدى الإنسان نوعان من القوانين، يصبح معنى ومفهوم محاربة المنكرات واضحاً، أي إذا وجدت البلديات والإدارات المختصة منطقة ملوثة فإنها تسارع إلى تعبئة طاقاتها وتدفع بموظفيها للقيام بحملة نظافة حتى لا يمرض الناس ولا تصيبهم الميكروبات، فإنه وبنفس النسبة بل وأكثر يجب الاهتمام بالمسائل الروحية والنفسية. عندما يجعل الميكروب روح وشخصية الإنسان عرضة للخطر تحت اسم المعصية والعصيان. فتشيع الرذائل والمنكرات في المجتمع، يجب أن تجتمع القوى وتعبأ للقضاء عليها وإزالتها. وكما أن للإنسان نوعين من المرض، فله أيضاً نوعان من السلامة، لأن الإنسان ذو بعدين. فأحياناً يمرض قلب الجسم وأحياناً يمرض قلب إنسانية الإنسان. أحياناً ترمض عين الرأس وأحياناً تمرض عين القلب أيضاً فتفقد قدرتها على الرؤية. وهكذا الأمر بالنسبة للأذن، وقد ذُكر هذا الأمر في القرآن:
﴿ولقذ ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنسان لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون﴾. إذن وكما يُعتنى بسلامة الجسم يجب الالتفات إلى سلامة الروح أيضاً لكن عبر طريقتها الخاصة. وحول هذا الأمر يقول أمير المؤمنين عليه السلام: "مالي أرى الناس إذا قرب إليهم الطعام ليلاً تكلفوا إنارة المصابيح ليصروا ما يدخلون في بطونهم ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعمالهم". هذا هو الضرر والخسران عندما يوجه الإنسان مرضاً معيناً فإنه يستخدم مجموعة من التدابير. كعدم تناول أنواع من الأطعمة، وعدم التكلم وأمورا أخرى، ولكنه لا يدقق في مواجهة أهل الفحش والمنكر مع أنه أسوأ بمراتب من المرض العضال.
على كل حال يجب أن نعلم لأجيال اللاحقة أنه لا يمكن ارتكاب الأعمال السيئة والمنكرات بمقتضى الإنسانية، لأن فطرة الإنسان الطاهرة لا تقبلها، يجب أن تخاطب المرأة فنقول لها: أنت امرأة ولديك دور معين في نظام الخلقة، ليس من شأنك التحلل والتعري، فهي عوامل تسبب لك السقوط والانحطاط. تقول سيدة نمساوية التزمت بالإسلام في كتاب تحت عنوان جاذبية الإسلام: "أحد أفضل قوانين الإسلام التي تعطي للمرأة قيمة، قانون الحجاب". لقد فرض الطاغوت ومن خلال ثقافته على المجتمع وأزال من الأ5هان مضار عدم الحجاب. وصارت المرأة في عصرنا الحاضر لعبة، متحللة، وقد ظهرت هذه الأمور وراجت بسب عدم معرفة أهمية المرأة ومقامها. وبدل أن تقارن المرأة نفسها بآسية، سمية والأخريات. فإنها تسعى لتقليد صوفيا لورين. يجب أن تقول للإنسان: عندما يأمرك الإسلام بعدم الكذب لأنه من المنكرات فهذا بسبب أثره السيء في كل الحركات الروحية، وحتى الجسدية وطبيعة الإنسان لا تقبل به، أو عندما نقول للمرأة: متانة وشخصية المرأة في وقارها وعفتها، وتقتنع بهذا الأمر وتدرك أضرار سوء الحجاب فإنها سوف تسعى لإصلاح نفسها شيئاً فشيئاً.
المسألة الأخرى التي يجب الإشارة إليها، هي تنظيف المجتمع من مظاهر المنكرات، الإسلام يحارب المنكرات بأبعاد مختلفة. فهو من جهة يرشد الإنسان إلى الإضرار التي تسببها حتى يمتنع عنها، ومن جهة ثانية يطهر المجتمع. لا يمكن السماح في الدولة الإسلامية أن يتلوث المحيط الاجتماعي، وما دامت مظاهر السوء موجودة في المتاجر والمحال تجب محاربتها وتطهير المجتمع منها. لهذا السبب يحارب الإسلام مظاهر الفساد. فلا يجيز لذوي الأعذار أن يأكلوا ويشربوا في الأماكن العامة، لأن هذا العمل يلوث المجتمع ويقضي على قداسة الصوم وقبح الإفطار، وهكذا أيضاً في مسألة الحجاب فإنه يتشدد مع غير المحجبات. يجب أن نوضح للمجتمع أن الإنسان موجود قيم يمكنه أن يصبح كاملاً، ولا يمكن أن تتكامل شخصيته إلا في إطار الارتباط بالله والقوانين الإلهية، وبهذه الطريقة فقد يزول اضطراب البشر.



















