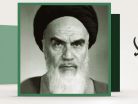أول الكلام: المعيار في العمل

الشيخ يوسف سرور
لما كان العمل ساحة، فيها ينتج البشر حاجاتهم التي هي متبادلة فيما بينهم. ولما كان ساحة، فيها يجهد الكثيرون على إبراز مواهبهم وإبداعاتهم. ولما كان ميداناً ينزل إليه آخرون من أجل تحقيق طموحاتهم وآمالهم، يعتبرون غاية سعادتهم في تحقيقها. ولما كان العمل حلبة، يجد البعض أن لديه طاقة وقوة يريد أن يظهرها، فيظهرها فيها. فهو إذاً، المساحة التي تتحقق فيها مصالح الناس ، بكافة شرائحهم ومستوياتهم. وهو بامتياز، المنطقة المشتركة التي تتعلق فيها حقوق كافة الأفراد من بني البشر؛ وليست هي حكراً على أية فئة أو مجموعة. فلما كان العمل مكاناً حقيقياً تُنتج فيه أسباب استمرار النسل البشري فهو يصلح أن يكون إطاراً حقوقياً بكافة المعاني والمقاييس، تتحدد فيه الحقوق والواجبات، التكاليف والامتيازات، الحدود والصلاحيات. ولما كان العمل ساحة مشتركة بين كل أهل الأرض، فلا يحق لأحد أن يتفرد بهذه الساحة، ولا أن يوزع الحقوق والحصص والأسهم على مزاجه.
ولا يجوز لأحدٍ أن يُقصي أحداً، ولا أن يظلم أحداً أو يُنقصه حقَّه. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كانت الأرض للَّه، والخلق كلهم خلق اللَّه، وإذا كانت الحاجات والميول والرغبات والطموحات والغايات، كلها تختلف، فلا يحق حينها للبشر الذين هم شركاء أن يحددوا المعايير والحقوق، بل هو حقٌّ حصريٌّ للَّه؛ وهو من بَعْدُ حقٌّ لمن يمنحه اللَّه حق الولاية على الأرض والعباد. وعليه، يجب أن تكون التشريعات الإلهية هي المصدر الوحيد في تحديد الحقوق والواجبات، والتكاليف والصلاحيات. ويجب أن يكون من يوليهم اللَّه على خلقه هم قدوة خلقه وأسوة عباده في العمل. ويجب أن يكون الدافع في العمل، في سد الحاجة، في تحقيق الميل والرغبة، في الوصول إلى الطموح والغاية، الهدف في كل ذلك يجب أن يكون التقرّب إلى اللَّه تعالى.
بمعنى أنه ينبغي أن يعطي الإنسان بُعداً أخروياً لعمله، ويرى أن لهذا العمل انعكاساً وتجسيداً في يوم القيامة. وحيث إن الحساب في الآخرة بيد اللَّه، وإن المبدأ كان من اللَّه، وإن التشريع بيده تعالى؛ كان التقرّب إليه في العمل أمراً طبيعياً. بل أكثر إذا عرفنا ما تقدم كانت نية القربى إليه تعالى أمراً بديهياً. وعليه فلا يجب أن يكون معيار العلاقات بين العاملين وفي سوق العمل، محكوماً بالربح والخسارة المادية ولا أن يكون المعيار في قرب الأشخاص العاملين من الآخرين، أو من بعضهم علو المنصب والشأن وكبر المسؤولية الظاهرية، بل يجب أن يكون البُعد الإنساني هو الحاكم في مثل هذه العلاقة فالناس صنفان: إما أخٌ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق.
لكن الذي نراه اليوم، هو أن الغالب على علاقات العاملين فيما بينهم حتى في مجالات العمل الإسلامي هو التصنيف وفق المسؤولية والمنصب، فنرى التعامل مع أصحاب المناصب يتم باحترام زائد، حتى من قبل المراجع الحقوقية، فإذا كانت هناك قضية أحد أطرافها ذو منصب فإنه يُراعى جانبه أكثر من الآخر. في المقابل نرى أن علياً عليه السلام لم يقبل من القاضي حين ناداه بالكُنية بينما نادى خصمه باسمه في قضية الدرع المشهورة مع اليهودي. ونرى أن حقوق أصحاب المناصب والمسؤوليات غالباً ما تُصان، بل أحياناً يُعطون امتيازات ليست لهم، في المقابل، إن الآخرين كثيراً ما تهدر حقوقهم ويُضيق عليهم، ويظل سيف المراقبة والمحاسبة مُصْلتاً على رقابهم، يتم هذا من جهة ومن جهة أخرى، يُصنّف العاملون أحياناً بحسب البيوتات التي ينتمون إليها، فإن أبناء الذوات وأصحاب الأسماء نراهم يُحافظ على حقوقهم ويُزادون، بينما العاملون من الناس العاديين توضع حدودهم "على الزعرورة" في الحقوق والامتيازات، وتُفرض عليهم كامل الواجبات ويُزادون بفرض أعمال أخرى عليهم أحياناً كثيرة. ومرة ثالثة نجد أن العاملين يصنفون بحسب القرب من المسؤولين وأصحاب المناصب. فالقريب الذي يتزلف المسؤول ويُغدق عليه الهدايا، ويكيله المديح، ويتنازل عن حقه أو عن رأيه أمامه، هو المقرّب الذي يُمنح الإجازات والامتيازات والأعطيات وغيرها، وإذا قصّر يُغضّ النظر عنه. في المقابل الذي لا يفعل ذلك مع المسؤول فإن العين عليه حمراء وأكثر، ومقصّ الرقيب مُسلَّطٌ على تصرفاته وأعماله وعلى راتبه. كل هذا يحصل في بلدنا.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، رضينا عن اللَّه قضاءه، وسلّمنا للَّه أمره (نهج البلاغة، ح37).