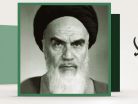منبر القادة: أسترزق ربي فيرزقني

الشيخ الشهيد راغب حرب رحمه الله
الثورة الحسينية مدرسة، وكل حدثٍ من أحداثها هو فصل مهمّ من فصول هذه المدرسة، وكل بطل من أبطالها هو معلّم قدوة باللسان والعمل، قد ختم علمه بالدم. والمجالس الحسينية مباركة ميمونة يرضى الله تبارك وتعالى عنها، وتقرّ بها عين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تستنير العقول بنور الإسلام، وتمتلئ القلوب حبّاً لله وبغضاً لأعدائه، ولأعداء الإنسان الذين إذا تولوا، سعَوا في الأرض، ليُهلِكوا الحرث والنسل، والله لا يريد ظلماً بالعباد.
فروح الثورة الحسينية الإيجابيّة قادرة على اختزال المسافات والأبعاد. وبساطة الثورة الحسينية هي في نظرتها إلى الأمور نظرة غير معقّدة، وهي تتعامل مع الأشياء تعاملاً مباشراً دون مواربة, لأنّ الإسلام خياره واحد، وهو أن يقف على قدميه، كاشفاً عن وجه واحد غير متلوّن وغير متعدّد الأشكال.
لقد تعلّمنا من هذه الثورة المباركة أن الضلال لا يمكن أن يتحمَّل الحق أبداً. ولو استطاع الباطل أن يُخرج الحق من جحور الهوام لاستخرجه وقتله. وهذا ما عبّر عنه قول الإمام الحسين عليه السلام يوم حدّثه ناصح بأن يذهب إلى شعاب اليمن، فقال: "لو كنت في جحر هامّة من هذه الهوام، لاستخرجوني منه حتى قتلوني!"(1).
لقد سيطرت على أهل الكوفة الروح الفردية، وأدّت هذه الروح إلى خذلان الحسين عليه السلام، فالذين خذلوا مسلم بن عقيل لم يكرهوا الحسين عليه السلام، بل كانوا يحبّونه، وكانوا يحبّون مسلماً، ويحبون منهج أهل البيت عليهم السلام، ولكن كل واحد منهم كان يقول في نفسه: لو رجعت إلى بيتي ما نقص الجيش شيئاً، ولبقي عدد آخر من الناس يقومون بهذه المهمة، وهي قتال الأمويين، وإسقاطهم عن عروشهم التي كانت تعيث في الأرض فساداً.
إن حبّ الدنيا كان يحرّك الكثيرين ممن واجهوا الحسين عليه الصلاة والسلام، كعمر بن سعد، وعمرو بن الحجّاج، وغيرهما ممن كان يُفترض أن يكونوا في صفوف الثورة، بدلاً من أن يكونوا في صفوف أعدائها، فقد اختار هؤلاء هذا الاختيار السيئ؛ لأنَّ الدنيا التي ملكت قلوبهم هي التي ألقت بهم إلى الحضيض والهاوية.
*في الثورة شباب وشيوخ
أُريد أن أتعرّض لجانب آخر من جوانب هذه الثورة، وهو أن أنصار الحسين عليه الصلاة والسلام الذين قتلوا معه في كربلاء والكوفة بلغوا حوالي المائة ونيّف، بمن فيهم مسلم وهاني بن عروة وابن عقبة الذين قُتلوا في الكوفة، وهذه نقطة جديرة بالبيان وبالتوضيح.
ولم يكن الثوار الحسينيون جيلاً متساوياً من حيث العمر، وإن غلب هذا الأمر على الثورات والحركات الاجتماعية في الدنيا، فالشباب هم عنصر الثورة باستمرار. ولكن في الثورة الحسينية كان موجوداً الشباب اليافع من أمثال القاسم بن الحسن عليه السلام، وعلي بن الحسين الأكبر عليه السلام وغيرهما، وكان فيها الشيوخ المسنّون من أمثال حبيب بن مظاهر عليه الرّحمة، ولم يكن اندفاع الشباب أكثر من اندفاع الشيوخ.
كان الشيوخ يقاتلون بحماسة الشباب في كربلاء، حتَّى قيل عن أحدهم إنّ تجاعيد جبهته قد بلغت حدّاً بحيث تُعيق الرؤية الواضحة لديه؛ لأنَّها تهدَّلت على جبينه، وغطّت شيئاً من عينيه، فلما أراد الخروج للقتال بحماسة الشباب، أخذ قطعة من الثياب، وشدّ بها جبينه حتى يبصر طريقه بوضوح.
*لا "سن تقاعد" في الإسلام
كان في المعركة رجال تجاوزوا السبعين والثمانين من العمر، وكان فيها فتية لم يبلغوا الحُلُم، فضلاً عن الشباب من أبناء العشرين والثلاثين، وكان هذا الجيش يُمثّل أجيالاً مختلفة.
والسرّ هو نظرة الإسلام إلى موضوع الشباب والكهولة، فالإسلام لا يعترف بشيء اسمه سن التقاعد، وهو يرفض الروح الاستهلاكية التي تعيش على حساب الآخرين، وخصوصاً على المستوى الاقتصادي، وإن وُجِدَت في أيامنا دعوة إلى أن يجلس الإنسان في بيته عندما يصل إلى سنّ محددة، فلا يكون منتجاً. والواقع هو أن علينا أن نفرّق بين شخص لا يجب أن يشتغل، وبين شخصٍ لا يجب أن يرهق نفسه إلى الدرجة التي يتحوّل فيها إلى إنسان غير معتنٍ براحته وصحته وعلاقاته الاجتماعية وواجباته الدينية. ومعنى ذلك أنَّه لا يجب أن يكون هناك إفراط ولا تفريط.
*دين الاعتدال
الإسلام هو دين الاعتدال، لا يقول لك: "اشتغل إلى الحدّ الذي تسقط فيه كل علاقاتك الاجتماعية". ولا يقول لك أيضاً: "اقعد في البيت، وكن عالةً على غيرك اقتصاديّاً ومعيشيّاً"، فإنَّه لا يقبل الإنسان الذي لا يعمل، حتى وإن كان هذا الإنسان غنيّاً؛ لأنَّ مقياس العمل في الإسلام يختلف عن هدف العمل في المبادئ الأخرى. فالعمل في الإسلام هو استرزاق الله، ولا يكفي في هذا الإطار الدعاء، فإنَّه وحده لا يرزق، وإنَّما الذي يرزق هو العمل، لذا قال الله في الكتاب الكريم:﴿جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولاً﴾ (الملك: 15)، أي: طيّعة، وأنتم تعرفون أنَّ تعبير الذلول في اللغة العربية يستعمل للدابة، وهذا ما يتمَّ عندما يؤهّل الفلّاح دابّته من أجل الحراثة، أو من أجل الركوب.
يقول الله تعالى إنَّه جعل الأرض ذلولاً، أي: طيّعة في أيديكم: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (الملك: 15).
العمل في الإسلام هو استرزاق الله، ويسترزق الإنسان ربه لأمرين: لأمر الدنيا، ولأمر الآخرة. لذلك يقول الله تبارك وتعالى عندما يتحدّث عن قارون:
﴿إنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ [-أي: لا تطغى-] إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآَخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْض﴾ القصص: ( 77-76).
فالإسلام يبيّن من خلال هذه الآيات أن المسلم يستعمل رزق الله في ربح آخرته، ولكنه لا ينسى نصيبه من الدنيا.
*ظنّ أنّه يعظ الإمام!
يروى أن الإمام محمد الباقر عليه السلام كان بديناً، وقد مرّ به أحد الزهّاد، فرآه يعمل عند الظهر بالعراء، والعرق يتصبّب منه، فقال: هذا شيخ من شيوخ بني هاشم، وهو متعلّق بالدنيا إلى هذا الحدّ، سأذهب لأعظه، فقال له: أيّها الشيخ، لماذا هذا التكالب على الدنيا؟ ماذا تفعل لو قبضك الله على هذه الحال؟
فأجابه الإمام عليه السلام: "يا هذا، لو قبضني الله على هذه الحال، لكنت على أحبِّ حالٍ أُحِبُّ أن ألقى الله عليها. أنا أخرج، فأسترزق ربي، فيرزقني وأوسع على نفسي وعيالي، وقد أوسع على جيراني، وقد أُنفق في سبيل الله. فقال هذا الزاهد في نفسه: لقد جئت لأعظه، فوعظني!"(2).
يرى الإسلام أنَّ الإنسان ما دام قادراً على العمل، لا بُدَّ له أن يحافظ على هذه الوتيرة، ولا يجوز له أن يقصّر في هذا المجال مطلقاً.
يهتمّ الإسلام بوضع النظام، وقد جعل للصلاة مواقيت، ومحطات ثابتة ومنظّمة وكذلك هي الحال بالنسبة إلى الحج والصوم. فلا ينبغي أن يكون العمل لطلب الرزق مانعاً عن أداء الواجبات العبادية.
إنَّ العمل أمر عظيم، ولا بُدَّ للإنسان من أن يعمل حتّى وإن كان مستغنياً عن المال، فإنَّه عندئذٍ ينفق من رزقه في سبيل الله كما كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام.
لقد كان أمير المؤمنين عليه السلام زاهداً وفقيراً على الرغم من أنَّه لم يترك فترة من حياته بلا عمل. وتؤكّد روايات كثيرة على أنه قبل أن يتولى الخلافة كان يعمل في بعض الأحيان بحفر الآبار بالأجرة. وكان يعمل أحياناً في بعض البساتين(3)، وكان ينفق. كان فقيراً لكثرة إنفاقه، لا لقلّة إنتاجه، وقد استشهد، وليس له من تركة إلّا سبعمائة درهم(4)، لأنه كان كثير النفقة في سبيل الله.
*المهم العمل بالتكليف
إذاً، ليس في الإسلام سنّ تقاعد، وإنَّما على الإنسان أن يقوم بواجباته التي أمره الله بها في إطار التكليف، وليس صحيحاً ما اعتبرنا عليه من الخطأ الشائع في اعتبار ابن العشرين صغيراً، ونتجاوز علما يفعله من المنكرات. بل هو إنسان مكلَّف، لأنه بلغ الخامسة عشرة من عمره، فلا بُدّ أن يلتزم بالتكليف ما دام على قيد الحياة.
فالجهاد، مثلاً، واجب على الشيخ الكبير، وعلى الشاب الصغير، إلّا الذي لا يقدر، لذا نجد أن المسلمين الأوائل كانوا يتنافسون على الجهاد لشدَّة شوقهم إلى الله.
توجد قصة معروفة جدّاً عن رجل اسمه عمرو بن الجموح، وقد كان رجلاً أعرج، فلما كان يوم أحد، وكان له بنون أربعة يشهدون مع النبي صلى الله عليه وآله و سلم المشاهد، أراد قومه أن يحبسوه، وقالوا: أنت رجل أعرج، ولا حرج عليك، وقد ذهب بنوك مع النبي صلى الله عليه وآله و سلم، فقال: بخ، هل يذهبون إلى الجنة، وأنا أجلس عندكم؟
وجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن قومي يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنت، فقد عذرك الله، ولا جهاد عليك، فأبى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم أن لا تمنعوه، لعلّ الله يرزقه الشهادة، فقتل عليه الرحمة، وقُتِلَ أبناؤه الأربعة، وأخو زوجته في أُحُد، فجاءت زوجته، فحملت الجثث على بعير، ووضعت ثلاثة في جانب، وثلاثة في الجانب الآخر، وما إن وصلت إلى المدينة، حتَّى استقبلتها النساء، فقلن لها: ما وراءك؟ قالت لهم: أما رسول الله، فهو بخير، وكل خطب دونه يهون، قالوا لها: وما هذه الجثث؟ قالت: هذا زوجي وأولادي وأخي، أكرمهم الله بالشهادة، أحملهم لأدفنهم(5).
إذاً، يبعث الإسلام في الإنسان هذه الروح، ومعنى ذلك أن الإنسان ما دام حيّاً، يجب أن يكون له دور يقوم به. وليس مقبولاً في الإسلام أن الإنسان إذا بلغ سناً محدّدة يُقال له: هذه سنّ مأوى العجزة، لا دور لك، ولا حياة، ولا حنان. إنَّ هذا الأمر غير معقول في الإسلام، فما دمتَ حيّاً، يجب أن تشتغل، وأن تؤدي دوراً أو وظيفة، فكما يوجد دور للشباب، يوجد دور للكهول.
(*) خطبة ألقاها الشيخ الشهيد راغب حرب بمناسبة ذكرى عاشوراء، الليلة الخامسة بتاريخ 11-10-1983م.
1.بحار الأنوار، المجلسي، ج45، ص99.
2.جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، ج8، ص457.
3.النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، ج1، ص186.
4.ورد: "لما قبض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قام الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في مسجد الكوفة فقال: أيها الناس إنه قبض في هذه الليلة... وما ترك بيضاء ولا حمراء إلّا سبعمائة درهم أراد أن يشتري بها خادماً لأهله...". الكافي، م.س، ج1، ص457.
5.بحار الأنوار، م.س، ج2، ص130.