عقيدة: القضاء والقدر
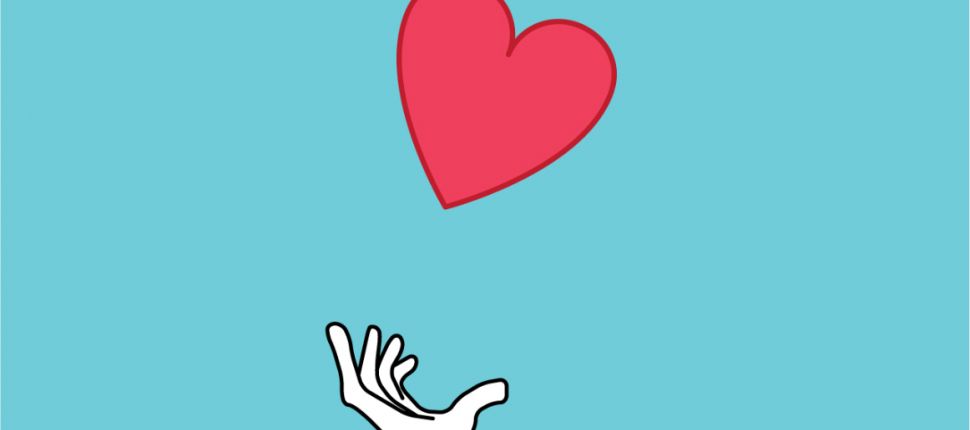
* لمحة تاريخية
إن مسألة القضاء والقدر من المسائل المطروحة في كل المدارس الإلهية والمادية. ولم يوجد إنسان يمتلك الحد الأدنى من الإدراك الإنساني إلا وقد شغلته هذه المسألة. وقد شرع المسلمون منذ النصف الأول للقرن الأول في الحديث عنها عندما واجهوا العديد من الآيات والروايات التي تذكر من جهة ضرورة الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهيين، ومن جانب آخر بضرورة الاعتقاد والإيمان بالإرادة الحرة للإنسان في تقرير مصيره؛ الأمر الذي أدّى إلى تعدد الفرق والمذاهب في هذه المسألة وأهمها ثلاثة:
1- فرقة سلّمت بشمول القضاء والقدر الإلهي لكل شيء حتى أفعال الإنسان الاختيارية (على ما يسميها غيرهم) إذ أنهم ينفون أن يكون للإنسان اختيار حقيقي (الأشاعرة). وهم القائلون بالجبر.
2- فرقة حددت نطاق القضاء والقدر بالأمور غير الاختيارية وعدّت أفعال الإنسان الاختيارية خارجة عن سلطته. وهم القائلون بالتفويض المطلق (المعتزلة).
3- فرقة حاولت الجمع بين شمول القضاء والقدر لأفعال الإنسان الاختيارية وإثبات الاختيار له في تقرير مصيره وتحديده. وهم الشيعة الإمامية القائلون ب (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين).
ولم تخلص المدارس المادية من هذا المشكل إذا أنها لما آمنت بقانون العلية، والذي من خصائصه المسلم بها أنه: أ- كل ظاهرة وحادثة وليدة علة أو علل أخرى. ب- إن وجود المعلول مع فرض وجود علته ضروري وقطعي. ج- إن عدم وجود العلة يؤدي إلى امتناع وجود المعلول، وهذه الخصائص من أركان فلسفة الماديين فإن السؤال ينطرح مجدداً:
هل أن أفعال البشر وأعمالهم نابعة من هذا القانون ولا يمكن استثناؤها منه؟ وبالتالي فأعمال البشر مشمولة لقوانين مسلّمة قطعية وجبرية، فكيف يكن تصور الحرية والاختيار. ولما كان لهذه العقيدة أثر كبير في حياة المسلمين السياسية والاجتماعية فقد دخلت في الميدان السياسي وبمفهومها الخاطئء الذي يؤيد أطماع الحكام في التسلط على رقاب المسلمين؛ بحجة أن الإنسان مجبور والله تعالى ينتخب الحاكم ولا يجوز لأحد الاعتراض وقد ساهم كل من الأمويين والعباسيين في حماية مسألة (الجبر) حتى أضحى المذهب الأشعري هو السائد العام في العالم الإسلامي. وقد قال معاوية (إنما قاتلتكم لأتآمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون) وكان أول من لفت الأنظار إلى فكرة الجبرية.
* تعريف القضاء والقدر
تارة يستعملان بصورة الترادف فيكون المعنى هو (المصير) وتارة يستعملان بصورة التباين، فكلمة القضاء تعني الحكم أو القطع والفصل والإتمام. وكلمة القدر تعني المقدار والتعين. فالحوادث الكونية من جهة كونها خاضعة لعلم الله ومشيئته الحتمية تندرج تحت القضاء الإلهي، ومن جهة كونها محددة بمقدار معين من حيث الموقع الزماني والمكاني تندرج في التقدير الإلُهي، وبلحاظ اختلاف المعنى، يكون القدر مقدماً على القضاء. لأنه ما لم يعيَّن مقدار الشيء فلا يصل الدور إلى إمضائه وإتمامه وقد ورد عن الصادق عليه السلام "إن الله إذا أراد شيئاً قدّره قضاه فإذا قضاه أمضاه". ويمكن مقايسة القدر والقضاء وتطبيقه على علاقة العلية والمعلولية حيث يعتبر القدر بمنزلة العلة الناقصة (أحد أجزاء العلة التامة) وهو يعطي إ مكان تحقق المعلول. والقضاء بمنزلة بعض العلة التامة (جميع أجزاء العلة) وهو يغير ضرورة تحقق المعلول.
* أمر بين أمرين
الاستقلالية بالفعل تحتم الاستقلالية بالوجود.
الاستقلالية بالوجود تحتم الاستقلالية بالفعل.
قلنا إن المسلمين واجهوا نوعين من الآيات القرآنية. بعضها يصرح بالقضاء والقدر ونفوذه المطلق لكل حادثة كونية، وبعضها تدل على كون الإنسان مختاراً ف عمله ومؤثراً في مستقبله ومصيره، وانقسم المتكلمون من العامة خصوصاً إلى مسلكين فكريين؛ طائفة تؤيد حرية الإنسان واختياره وعرفت (بالقدرية) في حين أيدت طائفة أخرى جانب التقدير الغيبي الصارم المتحكم وعرفت بالجبرية. وقد تواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "القدرية مجوس هذه الأمة" وكانت كل فرقة (الأشاعرة والمعتزلة) تنفي عنها هذه الصفة وترمي بها الفرقة الأخرى ففي حين يقول المعتزلة أن المقصود بها هم القائلون بأن القدر حاكم على أفعال الإنسان أجاب الأشاعرة بل المقصود بالقدرية هم الذين ينفون حاكمية القدر الإلهي على أفعال الإنسان.
والواضح أن المتكلمين جميعاً حسبوا أن لازم كون كل شيء مقدراً بتقدير إلهي أن يكون الإنسان مجبوراً في سلوكه فيستحيل الجمع بين الحرية والتقدير المسبق، فما قدر يجب أن يتحقق بلا اختيار وإلا فإن علم الله يتحول إلى جهل. وهكذا سعادته وشقائه أن لا يكون هناك تقدير سابق ولكن أليس من الممكن رفع هذا التعارض المدعى بين العلم الإلهي المسبق والمشيئة المطلقة وبين حرية الإنسان واختياره والتوفيق بينهما؟
الجواب: إن الاعتقاد بالقدر لا يعني الجبرية، بل إنما يستلزم ذلك لو لم نعط الإنسان أي دور في صنع سلوكه ومصيره مسلمين هذا الأمر للقدر فقط. والحال أن القضاء والقدر لا يعنيان إلا ابتناء نظام السببية العام على أساس العلم والإرادة الإلهية وإن مصير أي موجود مرتبط بالعلل السابقة والمرتبطة به كما قدّر ورتب بالعلم والإرادة الإلهية. فلو قصدنا من الاعتقاد بالقضاء والقدر هو التفكيك بين الأسباب والمسببات وبين الإرادة والاختيار الإنسانيين وأفعاله فهو خرافة ينفيها الوجدان قبل البرهان. فالإنسان خلق مختاراً حراً بمعنى أنه أعطي فكراً وإرادة. فليس الإنسان في أعماله كالحجر تدحرجه فيتدحرج ويسقط متأثراً بجاذبية الأرض دون أن تكون له أية إرادة، وإن الفرق بين الإنسان والنار المحرقة والماء المغرق وغيرهما هو عنصر الاختيار فكل هذه لا تنتخب طريقها، بينما الإنسان ينتخب طريقه بحرية.
وإن قصدنا من القضاء والقدر الارتباط الحتمي للعلل بالمعاليل فهي حقيقة مسلمة ولا أثر لذلك في إثبات الجبر... وبمعنى أدق: إن القضاء والقدر في الواقع عبارة عن انبعاث كل العلل والأسباب من إرادة الله مشيئته وعلمه وهو علة العلل، وعليه فالقضاء اصطلاحاً- هو العلم بالنظام الأحسن والذي هو منشئ وموجد لذلك النظام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قانون العلية العام يوجب الحتمية والضرورة فعند توفر الشروط التامة يكون وجود المعلول قطعياً وحتمياً ولا يقبل التخلف. كما أن عدم وجود المعلول في غير تلك الشرائط حتمي ولا يقبل التخلف أيضاً. فالقضاء والقدر هما عين الحتمية والضرورة.
وليس المقصود في قدرة الإنسان على تغيير المصير وتبديله هو قيام عامل قبال القضاء والقدر أو في قبال قانون العلية. فهذا أمر محال. لأنه لا يوجد عامل خارج عن نفوذ القضاء والقدر أو قانون العلية، بل إن تغيير المصير بمعنى أن يكون سبب التغيير هو بنفسه من مظاهر القضاء والقدر وحلقة من حلقات العلية أي أن تغيير المصير بموجب المصير وتبديل القضاء والقدر بحكم القضاء والقدر ومن هنا قيل إن الإنسان مجبور في اختياره.
وقد سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الحرز والدواء للاستشفاء، هل تستطيع أن توقف مسير القدر؟ فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم (إنها من قدر الله). وكان أمير المؤمنين يوماً تحت حائط مائل فانتقل إلى حائط آخر فقيل له: يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ فقال عليه السلام: "أفر من قضاء الله إلى قدر الله عزَّ وجلَّ".
ولذلك كان المسلمون يدعون الله أن يرزقهم أفضل القضاء. وقد سأل يوماً أمير المؤمنين أحدُ أصحابه: هل أن الإنسان يملك الاستطاعة والقدرة على أعماله؟ فسأله أمير المؤمنين عليه السلام: إنك سألت عن الاستطاعة فهل تدركها من دون الله أو مع الله؟ فسكت الرجل ولم يحر جواباً فقال عليه السلام: إن قلت أنك تملكها مع الله قتلتك وإن قلت تملكها دون الله قتلتك. قال الرجل ( ) فما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: تقول إنك تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن يملكها إياك كان ذلك من عطائه، وإن يسلكها كان ذلك من بلائه، هو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك.
ولتوضيح الفكرة نأتي بالبيان التالي:
إن القضاء والقدر على نوعين: نوع محتم وآخر يقبل التغيير وقد ورد في ذلك آيات مستفيضة. أما الأول فهو نافذ في الموجودات التي يمكن فيها نوع خاص من الوجود فقط، كالمجردات العلوية. ويمكن إضافة القوانين والنظام الحاكمة في العالم (السنة الإلهية) لها أيضاً فكون العاقبة للمتقين، وتغيير حال الناس لا يحصل إلا بتغيير أنفسهم وأن عاقبة الظلم الفناء كلها قوانين حتمية لا تختلف. وهذه يكون القضاء والقدر فيها حتميين. إلا أن هناك موجودات يكون فيها أكثر من نوع من الوجود وهي الموجودات المادية، فالمادة الطبيعية تقبل الصور المختلفة وفيها استعداد التكامل وتؤثر فيها بعض العوامل فتزيدها طاقة وقوة بينما تؤثر فيها العوامل الأخرى نقصاناً فالبذرة لو صادفت المحيط الملائم نمت ووصلت إلى كمالها ومع فقدان أحد العوامل الملائمة لن تستطيع النمو.
وفي القضاء والقدر في هذه الموجودات غير حتميين بمعنى أن نوع القضاء لا يعني مصيرها وإن سر الأمر في إمكان تبديل المصير يكمن في أن مواد العالم مستعدة في آن واحد للتأثر بعلل مختلفة هذا من جهة ومن جهة أخرى فالقضاء والقدر يوجب وجود كل موجود عن طريق علله الخاصة به وامتناع وجوده من غيرها. فما وقع من الأهوال هو بالقضاء والقدر الإلهي وما لم يقع هو بالقضاء والقدر الإلهي أيضاً.
* شبهة أخرى
في نهاية المطاف لا بد أن نتعرض لأشهر أشكال الجبريين التي ترتبط بهذه المسألة وهي أن الله عالم من الأزل فيما وقع وما يقع وعلمه لا يقبل التغيير ولا المخالفة للواقع، لذلك فإن الحوادث والكائنات يجب أن تجري بنحو ينطبق مع علم الله قهراً وجبراً حتماً وإلا استحال علم الله تعالى إلى جهل وهو محال عليه.
والإجابة على هذه الشبهة تتضح بعد معرفة مفهوم القضاء والقدر فإن الشبهة إنما حصلت بعد أن أعطي لكل من العلم الإلهي من جهة ونظام الأسباب والمسببات في العالم من جهة أخرى حساب مستقل بمعنى أنه فرض أن العلم الإلهي في الأزل تعلق صدفة بوقوع الحوادث والكائنات، ولأجل أن يكون هذا العلم علماً ولئلا يقع خلافه فقد لزم أن سيطر على النظام العالمي ويخضع للمراقبة الشديدة ليكون مطابقاً للتصور والتخطيط المسبق. ومن هنا يجب سلب الاختيار والحرية والقدرة والإرادة من الإنسان لتكون أعماله تحت السيطرة الإلهية ولئلا يتحول علم الله إلى جهل. والحقيقة أن العلم الأزلي الإلهي ليس مفصلاً عن النظام السببي والمسببي في العالم. والعلم الإلهي يتعلق بالحادثة من خلال علتها وفاعلها الخاص. فإذا كان هذا الفاعل الخاص لهذه الحادثة صدرت من هذا الفاعل قهراً أو جبراً كان ذلك مخالفاً للعلم الإلهي الأزلي. وبعبارة أخرى هناك الفاعل الطبيعي غير شاعر بفعله وهناك الفاعل الشعوري: وهناك الفاعل المجبور وهناك الفاعل المختار. وكل هذه علل خاصة لأفعالها. والعلم الإلهي يتعلق بهذه الأفعال والآثار من خلال عللها الخاصة. فهو يتعلق بالفعل اللاشعوري من الأول والفعل الشعوري من الثاني والفعل الجبري من الثالث. والفعل الاختياري من الأخير ولو حصل الفعل جبراً وقهراً من الفاعل المختار لكان ذلك مخالفاً للعالم الإلهي ولتحول علم الله إلى جهل تعالى عن ذلك علواً كبيراً.
* خاتمة
لقد ظن المستشرقون الكثيرون أن مسألة القضاء والقدر من أهم المسائل التي أدت إلى انحطاط المسلمين. والحق أنها من أرقى المعارف الإلهية. والمسلمون الأوائل أدركوها بالوجدان أكثر من علماء الكلام والفلاسفة. ولذلك لم نجدهم يتكاسلون ويتخاذلون بحجة هيمنة القضاء والقدر على مصيرهم بل نجد الجهاد والكد والسعي دأبهم حتى انتشر الإسلام في معظم أصقاع الأرض.
والحقيقة أن فهم هذه المسألة لمن أعظم الدوافع نحو العمل والنشاط من خلال ما تبعثه من أمل ورجاء كبيرين، فالعمل الإنساني بل الإرادة الإنسانية لا غير يمكنها أن تهز العالم العلوي وتسبب تغييرات ومحو وإثبات فيه وفي بعض الألواح التقديرية والكتب الملكوتية، ويمثل هذا أسمى سلطة للإنسان على مصيره، "فالدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراماً"، و "ومن يعيش بالإحسان أكثر مما يعيش بالأعمار" و"من يتوكل على الله فهو حسبه..." إلى ما هنالك من القوانين التي تجعل مصير الإنسان باختياره. حتى أنه يمكن أن يصل إلى درجة أن لله رجال إذا أرادوا أراد.
والحمد لله رب العالمين













