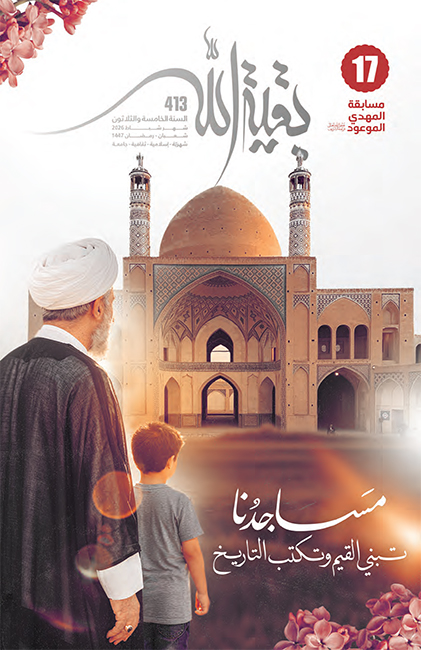نحو مجتمعٍ متكافلٍ يريده الله

الشيخ د. عليّ زين العابدين حرب*
عصفت بلبنان حربٌ ضروس عضوض، هي الأقسى بشهادة مَن عاش لحظاتها وزامن غيرها. ولم تكن حرب العدوّ الصهيونيّ على المجاهدين، أولي البأس فقط، بل كانت تتعمّد قتل العُزَّل والمدنيّين والطواقم الطبيّة، متجاوزةً أخلاقيّات الحروب. فسبّبت مشكلةً اجتماعيّةً صعبةً ومربِكة؛ بسبب كثافة النزوح واتّساع بساطه، وما فرض ذلك من إيواء وإسكان ورعاية وحماية. وسارع كثيرٌ – ممن لم يكبّلهم الجشع- إلى احتضان النازحين وكفالتهم إيواءً أو إطعاماً أو إكساءً أو غير ذلك، وأظهروا بذلك خصالاً نفسيّة نبيلة. لم يقتصر فعل الاحتضان على "بيئة المقاومة" فحسب، بل ظهر من انتماءات شتّى؛ ومن مجتمعات مختلفة بين محلّيّة وعربيّة وغير ذلك.
يقول الإمام الخمينيّ قدس سره: "هذا القدر من صلاح الدنيا الذي نجده، مردّه إلى جهود الأنبياء"(1) بهذا يكون التكافل فعلاً دينيّاً، لا محالة، فما هو أثره في المجتمع؟
* التكافل الاجتماعيّ وأشكاله
التكافل تفاعلٌ بين طرفين أو أكثر في فعل الكفالة، يتكفّل كلّ طرفٍ بأمرٍ يخدم به الآخرين. وهو تفاعلُ أدوارٍ وتعاونٌ بين أفراد المجتمع. وقد يأتي عمل البرّ، ورعاية المحتاج، وعون الضعيف كأشكالٍ بارزة للتكافل الاجتماعيّ. لكنّه لا يقتصر على ذلك؛ فهو ليس تعاوناً على سدّ العوز فقط، بل تعاون واسع على صون الحقوق وفعل الواجبات، ومنع الظلم ودفع الاستبداد وتحقيق الأمن ونشر العلم وتبديد الجهل.
وكذلك، يأتي التكافل الأسريّ، كرعاية المسنّين وحضانة الصغار، نوعاً من أنواع التكافل الاجتماعيّ؛ فالأسرة نواة اجتماعيّة من جهة التكوين والتأسيس والبقاء، وخليّة من خلاياه من جهة النماء والتطوّر.
وإذا كان التكافل الاجتماعيّ يشمل أدوار الأسرة، والمقاومة، والأمن، والتعليم، والتعاون بين الناس على سدّ الضعف وملء فجوات النقص؛ فإنّنا سنقتصر على شكله البارز، التكافل الاجتماعيّ، باعتباره الأكثر شيوعاً أيّام الحرب الأخيرة وما بعدها. وهذا لا يعني عدم وجود تكافل في بقيّة الأدوار خلال الحرب، كما هو واضح ولائح؛ فقد سجّلت المقاومة والأُسَر أبهى صور التكافل الاجتماعيّ. ولِقوّةِ أثرها، صارت بحدّ ذاتها عنواناً أصيلاً يُقاس عليه ويُقارن به، حتّى يمكننا القول إنّ التكافل فعلٌ مقاوم للظروف القاسية، وينبغي أن يكون كتكافل أفراد الأسرة الواحدة.
إذا كان هذا حدّ التكافل وإطاره، فكيف رغّب إلينا الدينُ فعلَه والمبادرة إليه؟
* الدين يحثّ على التكافل
قلّما نجد في نصوص الدين مادة التكافل بلفظها، فكثيراً ما نجدها بمعناها ولكن بألفاظ غزيرة كالتراحم، والبرّ، والتعاون، وعون المؤمن، وتنفيس الكرب عنه، وإدخال السرور عليه، والمساعدة في قضاء حاجته ودَينه، وغير ذلك. وبعضها أشار إلى الأجر بغير حساب، أو الثواب العظيم في الدنيا أو فيها وفي الآخرة. ويمكن مراجعتها في كتب الحديث، التي عقدت أبواباً لهذه العناوين(2).
وتستوقفنا حزمةٌ من هذه النصوص، ترفع الكافل إلى درجةً عاليةً، لا تُنال بسهولة. يذكر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّ كافل اليتيم معه في الجنّة، يرافقه على الدوام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة"(3)، وأشارَ بالسَّبَّابةَ والوسطى(4).
ومن جهةٍ أخرى، جعل الدين منزلة الكافل كمنزلة المجاهد في سبيل الله. يرشدنا الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: "إِنَّ اَلْمُسْلِمَ إِذَا جَاءَهُ أَخُوهُ اَلْمُسْلِمُ فَقَامَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّه"(5). إنّ الله يورد الكافل مورد المجاهد في سبيله، وهذا يعني نيل أعلى الدرجات في الجنّة، التي لا يُلقّاها إلّا ذو حظٍّ عظيم جدّاً.
وليس هذا الثواب مجرّد عطاء كريم، بل هو تنزيل لشيء في منزلة أخرى أشرف وأعلى. هو ثوابُ ترقية المنزلة والمقام عند الله، أو ما يمكن تسميته "ثواب التنزيل"، وهو يدلّ على أهميّة التكافل في ميزان الله.
وليس غريباً حينئذٍ أن يتضمّن القرآن الهادي دعوةً أكيدةً إلى التكافل، قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ (النحل: 90). وأخبر عن فوز المتّقين يوم القيامة بسبب التكافل الذي فعلوه في دنياهم: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (الذاريات: 19).
كما أنّ الكتاب الكريم تحدّث عن حال أولئك المهاجرين الذين تقطّعت بهم السبل، وتبرّأ منهم الأهل والولد، وحيل بينهم وأموالهم، قال سبحانه: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (الحشر: 8).
ثمّ أشار تعالى إلى وسام الفَلاح الذي يناله الأنصار المتكفّلون بالمهاجرين إليهم: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: 9). ويجري هذا الأمر مجرى الشمس والقمر، في كلّ عصر تهاجر فيه فئة الصادقين إلى الله وتعاني بسبب ذلك الفقرَ والوحدة والوحشة، وفئة المفلحين التي تؤوي وتنفق وتؤثر وتتلقّى بالحبّ والترحاب.
بعد كلّ هذا الحثّ والتشجيع على التكافل، آن لنا أن نعرف تأثيره الاجتماعيّ.
* أثر التكافل الاجتماعيّ
ليس غلوّاً القول بأنّ المجتمع إنشاء إلهيٌّ وتأسيس ربّانيٌّ، حين قال سبحانه: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: 30). وهو يقوم على الإنسان والطبيعة والعلاقة التي تربط الإنسان بالإنسان والإنسان بالطبيعة. وعلى الرغم من كون تأسيس المجتمع إلهيّاً، إلا أنّ الله جعل سيره اختياريّاً، فطلب من الإنسان أن تكون علاقته بالآخر استخلافاً منه واستئماناً لبلوغ الكمال، لا استعباداً ولا إفساداً. وكون الاستخلاف اختياراً إنسانيّاً إراديّاً، يجعل خطى المجتمع لبلوغ الكمال متفاوتة. فقد تسرع أو تبطئ، وقد تكون حثيثة أو وئيدة، وقد تتقدّم أو تتأخّر. وفي جميع ذلك، لا بدّ أن نلمح هذه الآثار والمعالم:
1. التكافل يجرّ التكافل: للتكافل آثارٌ فرديّة تكوينيّة تعود على الكافل أضعافاً في الدنيا والآخرة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: "أَيُّمَا مُؤْمِنٍ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً، نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا وَكُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَة"(6). وقد يكون تنفيس كربه في الدنيا من جانب كافلٍ آخر، بتقديرٍ من مُجري الأقدار سبحانه. ولعلّ هذا من سنن الاجتماع الإلهيّ، عندما يؤدّي التكافل إلى تكافلات كثيرة، وإلى البركة الإلهيّة في الأعمال والأعمار.
2. الكافل خليفة الله: قال عزّ من قائل: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ (الأنعام: 165). إنّ كلّ كافلٍ هو خليفة لله في واقعة تكفّله، وهو أمينٌ على صاحب الحاجة، أي أخيه الإنسان. فيكون بذلك مظهراً لفيض رحمته وعطائه، ينهض بالضعفاء والمحتاجين ومَن انقطعت بهم السبل بالهجرة والنزوح. لذلك، أجزل الله عطاء الكافل، ورفع منزلته إلى معالي القرب والقدس. وليس أحبّ إليه من أن تجد صفته (الرحمة) سبيلها إلى أوعية المقادير.
3. لا بدّ من كافل: هنا، تكمن القطبة الخفيّة. إنّ الله سبحانه منزّه عن أن يُرى، على الرغم من أنّه أقرب إلى عبده من حبل وريده، ويعجز العبد عن معاينته كما يعاين الأشياء. في الحديث الرضويّ: "كان الصانع متعالياً عن أن يُرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهراً"7)). فلن تُعرف رحمته إلّا في آثارها، ولن تجري إلّا في نظامٍ سببيٍّ رحمانيٍّ أو رحيميّ، من بشرٍ وغيرهم. ولسوف تظهر الأسباب البشريّة في أشكال التكافل الاجتماعيّ على تنوّعها، فيكون الكافل طريقاً لظهور رحمة الله ولطفه وواسطةً، بمعنى أنّ الله أجرى ذلك الخير على يدي الكافل.
4. تحقيق الأمن الاجتماعيّ: كما أنّه يفضي إلى الأمن الاجتماعيّ كلّما ساهم في الحدّ من الفقر وتقليص الفجوة مع الغنيّ.
5. تعزيز قوّة المقاومين: كذلك هو يعزّز من قوّة المقاومين، عندما يجدون من يتكفّل أمر مجتمعهم في غيبتهم.
6. المساهمة في التمكين الاقتصاديّ: بالإضافة إلى إسهامه في التمكين الاقتصاديّ، بحيث نجد مثال ذلك عقيب مؤاخاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، فقد اشتدّ عود بعض المهاجرين الذين تاجروا وحقّقوا الثراء فاستغنوا.
* آثار اجتماعيّة على الفرد
1. تطهير القلوب: لا تخفى بصمات التكافل الاجتماعيّ في اجتماع القلوب وتآلفها، فبعض نوازع الحسد أو الغلّ أو الضيق، لا تذهب إلّا بالعطاء والعون.
2. التطهير من آثار الذنوب الاجتماعيّة: وقد لا يُلتفت إلى أثر التكافل في التطهير من الآثار الاجتماعيّة للذنوب، بحيث يقول تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ (التوبة: 103).
إنّ الإنسان كلمة الله التي نشرها في أرجاء الأرض كلّها. وإذا كان التكافل الاجتماعيّ يمثّل مجرى لتدفّق الرحمة الإلهيّة بين الناس، فإن الكافل سيكون وسيلة لانعكاس صفات الله في مجتمعٍ تعدّديٍّ.
*أستاذ محاضر في جامعة المعارف_ بيروت، وأستاذ في الحوزة العلميّة.
(1) مختارات من خطب وأحاديث الإمام الخميني قدس سره، خطابه مع ممثّلي الطائفة الأرمنيّة في إيران، ص 685.
(2) يراجع: وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج 16، أبواب عمل المعروف، ص. ص 63-67.
(3) ميراث حديث شيعه، مهريزي، ج 17، ص 337.
(4) نور الثقلين، الشيخ الحويزي، ج 5، ص 573.
(5) المؤمن، الأهوازي، ص 56.
(6) المؤمن، مصدر سابق، ص 46.
(7) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 11، ص 40.