المقاوِم في "شتاء وغرباء": رائد عشقٍ... حتى مقاصير الشهادة
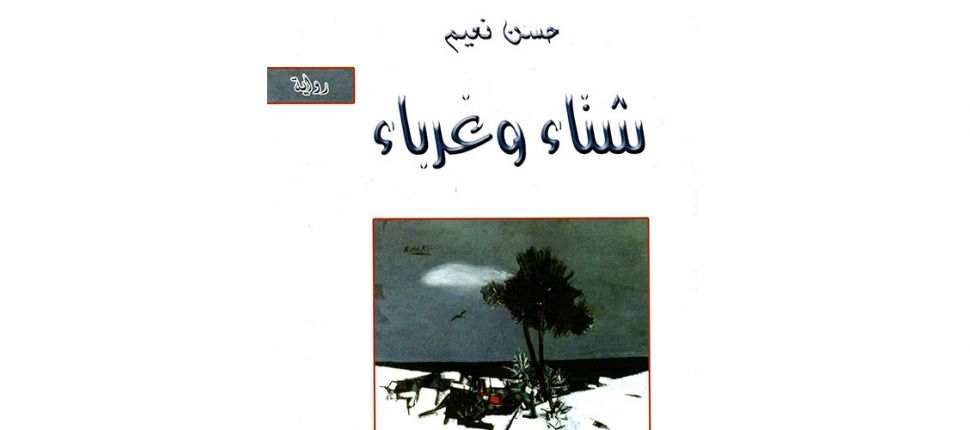
ولاء إبراهيم حمود
تتنوع ملامح المقاوم في "شتاء وغرباء" أُولى روايات حسن نعيم، ابن الهرمل، بلد المئة والخمسين شهيداً، خزان المقاومة. تتجدَّد هذه الملامح وتختلف، لدرجةٍ يصعب توحيدها وتأطيرها في إطارٍ واحد لعدة صور، لأن الرواية لم تغلق غلافيها على وجه "أمير" وحده شهيداً، مقاوماً. فأهالي "حيرى" (الذين ناموا على وسائد مبللة بالدمع) وضعوا على قبر الشهيد أكاليل الورد، وزرعوا حوله الزهور، واصطف شبابها حول القبر يؤدون صلاة الوحشة. وللورود والصلاة في ذاك الزمن معنى العهد والوعد بمتابعة طريق الشهيد، وقد يصبح الكل في هذا الطريق مشاريع شهادة...
لو أردنا أن نفتح ملفات المقاومة القديمة في "حيرى" وجوارها لوجدنا كبار السن من الرجال مقاومين يزرعون في نفوس أبنائهم حب اللَّه وطاعته.. فوالد "أمير" أبو دعاس مؤمن، شهم، مصلٍّ، وجيهٌ، مهيب ذو "وهرة" وقد "طنَّش" عن مشاركة "أمير" في يوم القدس. وهو في رفضه لمشاركة ابنه في المقاومة، إنما يسعى ليراه (مهندزاً). ودعاس الدروبي، النّزق، والعصبي، والقامع لزوجته سلوى.. والمجدِّف على اللَّه في بعض الأحيان والذي (.... سبَّ وشتم رجال الدين في مقرِّ المقاومة في "حيرى") بكى في تشييع الشهيد زاهر، وعاد إلى المسجد متهجداً... معلناً استعداده للمرابطة على تلال المقاومة جنوباً، بعد أن كان يتساءل (شو نحنا زارعين النخل بالجنوب؟)، مسترضياً "أميراً" بعد عودته من عدوان نيسان (هيدا صاحبك السيد حسن على التلفاز) (هودي ناس بينمشى وراهن، بدو يحكي ضميرو الإنسان). دعاس الدروبي، قاوم الفقر والطوفان، وأحب "أميراً" أكثر من أبيه وأمه ونفسه، "وهو الرجل البري الذي أدمنَ الوعد". وتلك كانت أولى عواطفه نحو المقاومة، التي كانت "عشق" أمير حتى الشهادة. حتى سلوى زوجته، فتحت على حسابها جبهة مقاومة داخلية. كانت تقاوم غضب دعاس وجفاءه، بزيادة جرعات الحب والعاطفة نحوه، دافعةً بالتي هي أحسن، إحساساً منها بتعبه وإرهاقه، وكذلك كانت معظم نساء "حيرى" في تعاطيهن مع رجالهن.
أما "ريتا" الفتاة المسيحية، التي أحبَّت في "أمير" هذا التماسك وتلك الشخصية، التي زحزحتها عن مرتبة التفوق العلمي، وعن عرش الجمال الذي تربعت عليه في قلوب الكثيرين ممن حاموا حولها وصدَّتهم، فقد كانت هي الأخرى في موقعها، مقاومة لذاتها أولاً عندما نقمت على أمير، ثم وجدت نفسها دون سابق إنذار أسيرة ملامحه الملائكية ومنطقه الشجاع الصادق. وكما لم تخفِ "ريتا" تباريح وجدها نحو "أمير" عن رفيقاتها وأمها، كذلك لم تخفِ إعجابها بالمقاومة الذي بلغ حدّ "التشيؤ" بإلغاء إنسانيتها متمنية أن تصبح صاروخاً يخدم المقاومة بالانطلاق نحو المستعمرات منفجراً فيها، مبعداً عن المقاومة وأمير وإخوانه خطرها. وقد حسمت بعد استشهاده قرارها فارتدت ثياب الراهبة وأعلنت عند ضريحه عشقها للتراب الذي تدوسه قدماه.. وما كان ذاك التراب سوى ذاك المجبول بنجيعه ودماء إخوانه من المجاهدين. إذاً، ككل المقاومين، بدت ملامح المقاوم في الرواية، ملائكية، نقية، ملامح فتىً في مقتبل العمر يحرص على أداء الصلاة المستحبة، وذلك بالامساك بحبل يمتد من منزله إلى منزل زاهر وحيدر (مقاومين وقريبي أمير) قبل النوم، كي توقظه اهتزازاته الأولى. ومثلهم كان أمير شجاعاً، مقداماً، صادقاً، مرحاً يمتلك روح النكتة اللاذعة، والتي لا يرفضها حتى من تلف عليه شباكها، فزاهر في آخر وداعٍ لأمير مازحه (رايحين عامودي، مين بيعرف يمكن نرجع أفقي). وأمير يمازح أستاذه الياس (خفف أكل لحم ت يرق قلبك القاسي وتلاقي بنت الحلال). لم يقصد حسن نعيم في روايته تلميع صورة المقاوم في شخص "أمير"، على حساب "أمير" نفسه، أو على حساب الشخصيات الأخرى.
لم يرد نعيم عمداً أن يحافظ "أمير" على دور البطولة فيها، حتى ما بعد المشهد الأخير، بين "ريتا" وضريحه المكلل بالصلاة والورد، لأن الآخرين أيضاً، كانوا أبطالاً كلٌّ في ميدانه. إن الصدق ودقة الريشة التي استخدمها حسن نعيم في مزج ألوان البطولة بالمقاومة في هذه الرواية، سلطت الضوء على مجتمعٍ مقاومٍ بكل شرائحه، برجاله، ونسائه وأطفاله، الذين يحترفون الرفض صغاراً (ثورة الأطفال بالحجارة على قرار إلغاء الرحلة السنوية، حقهم المكتسب بحكم العادات الترفيهية). عِلْماً أنّ الصورة الواقعية التي قدَّمها حسن نعيم لأمير كمقاوم هي ذاتها صورة دعاس المقهور بالطوفان ونكبات الموسم الزراعي.. فأمير أحب "ريتا" وأحبَّ أن يخوض في بحار عينيها الزرقاء والساكنة سكون الليل. وشارك لأجلها في رحلةٍ اضطر فيها إلى اعتزال الرفاق، رفضاً لمشاهدة المحرمات والوقوف إزاءها متفرجاً وفي ذلك خيانةٌ لدينه، لكنها "ريتا" التي رمَت في النهرِ إكراماً له قنينة البيرة من يدها.. وختمت نقاشها معه؛ بإعلان رؤيتها له في هالة من الاحترام جعلته أمامها، في حجم إسلامه، فكبر قلبه بكلمتها الطيبة التي أعطت للرحلة ختامها الشرعي. ولكن "أميراً" يتميز عن سواه من أبطال القصة حتى المقاومين منهم، بلمعة الذكاء والتفوق العلمي و"الحنية الغريبة" التي هي (الحنان) الذي وصفته به أمه.. يلاحَظ أن الأبطال، يدرك بعضهم بعضاً معرفة الإنسان لنفسه ودخائلها.. كلٌّ يقدم الآخر إلى الآخر. لعبة فنيةٌ لا غبار عليها هي لعبة الحياة أتقنها حسن نعيم بمصداقية المقاوم مع مقاومته فلم يتدخل في إبراز شخص وطمس آخر. ترك الكل يتحرك أمامنا بعفويته، وترك لنا نحن القراء الحكم، لا للرواية أو عليها؛ بل للبطولة في الجهاد الأكبر، جهاد (أمير) الذي نأى بدينه عن دائرة الاحتراق، حتى بنارِ وميض المشاعر النبيلة تجاه "ريتا". وفي تحركهم جميعاً، حمل كل منهم سلبيات شخصيته قرب إيجابياتها. مما أقنعنا جميعاً أنهم واقعيون مئة بالمئة، وأن حسن نعيم يغرف من معين هذه الواقعية التي جسَّد فيها بروايته أهم صانعي خصائص هذه البيئة المقاومة في الشمال الشرقي من وطن المقاومة. ولئن تميز زاهر وأمير في ختام الرواية بفوز الشهادة، فهما تميزا أيضاً بفتح أحداثها على يقين النصر المبين في الخامس والعشرين من أيار من العام ألفين، كما تميز نعيم بامتلاكه اليقين الأكيد بهذا النصر... فبشرنا به في روايةٍ تستحق أن تُقرأ، وأن نقرأ فيها نحن جمهور المقاومة ملامح جنودها وشهدائها في إطارها الطبيعي الذي أحسن نعيم تأطيرها به، كرواد عشقٍ حتى تخوم الشهادة.













