الآداب المعنوية للصلاة: حب الدنيا المانع الأكبر من حضور القلب
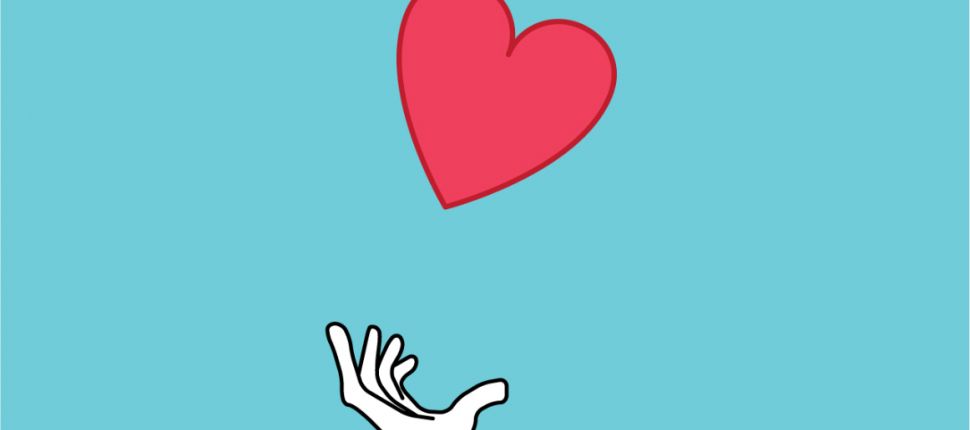
يقول الإمام الخميني قدس سره: إن الدعوة إلى الدنيا خارجة عن مقصد الأنبياء العظام بالكلية. ويكفي في الدعوة إلى الدنيا حس الشهوة والغضب والشيطان الباطن والظاهر، وهي لا تحتاج إلى بعث الرسل.
في الحديث عن الآداب المعنوية للصلاة، فإن حضور القلب يعد من أهم الشروط والآداب الباطنية وهو أساس قبول الصلاة وتحصيل فوائدها النورانية. ولكن يوجد مجموعة من الموانع التي تقف سداً منيعاً أمام حضور القلب في الصلاة، منها تشتت الخيال وكثرة الخواطر ومنها انشغال القلب بحب الدنيا الذي يعمي صاحبه عن المطلب الحقيقي.
ولأجل معالجة هذا الأمر الحساس الذي لا ينجو منه إلا الكمل من أولياء الله تعالى ومن شاء الله يذكر الإمام قدس سره مسألتين أساسيتين:
- الأولى: رفع شبهة رائجة حول العلاقة بالدنيا.
- الثانية: الإشارة إلى خطورة حب الدنيا وعاقبته.
وحول المسألة الأولى، فمن المعروف أن هناك حديثاً يدور بين المسلمين حول العلاقة بالدنيا منشؤه تلك النظرة الأحادية الجانب التي تأخذ ببعض الروايات دون بعض، ولا ترجع إلى المحكم بل تنيخ إلى المتشابه لمرض أو زيغ في القلوب.
فمن الروايات التي يستند إليها البعض في تبرير تعلقهم بالدنيا والانشغال بها جاهاً ومالاً قول أمير المؤمنين عليه السلام: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً" أو الآيات الشريفة مثل: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده..﴾ وغيرها من الآيات والأحاديث التي تشير إلى الدنيا بطريقة إيجابية يستفيد منها أصحاب الدنيا لتبرير إقبالهم على الملذات والشهوات المحللة. ثم يستنتج هؤلاء بأن الإسلام دين الدنيا ودين الآخرة. ويجيبهم الإمام قائلاً:
"وإن الذين يظنون أن لدعوة النبي الخاتم والرسول الهاشمي صلى الله عليه وآله وسلم جهتين: دنيوية وأخروية، ويحسبون هذا فخراً لصاحب الشريعة وكمالاً لنبوته، فهؤلاء ليس عندهم معرفة بالدين، وهم عن مقصد النبوة ودعوتها غافلون".
بينما نجد ما فهمه أهل الدنيا من الأحكام الإلهية المتعلقة بالدنيا إنما هو الدعوة إلى تحصيل الدنيا. والواقع أن من أكبر الشبهات الأخلاقية المنتشرة في مجتمعنا الحالي هي ما يتعلق بهذا الأمر الذي يحمل شعاره أولئك المتلبسون بلباس العلم الذين استطاعوا أن ينالوا حظاً رفيعاً من الجاه والمال نتيجة موقعهم الاجتماعي الذي يرجع على أساسه كل من يريد دفع الحقوق الشرعية إليهم. ولتبرير حالهم عمدوا إلى هذه الخدعة الماكرة وأسقطوا أساس دعوة الأنبياء من النفوس وجعلوا يبررون لأهل الدنيا تكالبهم عليها.
يقول الإمام قدس سره:
"إن إدارة الشهوة والغضب لا تحتاج إلى القرآن والنبي، وإنما الأنبياء بعثوا لينهوا الناس عن التوجه إلى الدنيا، وإنهم ليقيدون إطلاق الشهوة والغضب ويحددون موارد المنافع. والغافل يظن أنهم يدعون إلى الدنيا. إن الأنبياء يقولون إن المال لا يجوز تحصيله كيفما كان، ونار الشهوة لا يجوز إطفاؤها بأي نحو، بل لا بد من إطفائها عن طريق النكاح. وهكذا تحصيل المال، فلا بد من أن يكون عن طريق التجارة والصناعة والزراعة، مع أن في أصل الشهوة والغضب إطلاقاً.
فالأنبياء يصدون طريق إطلاقهما، لا أنهم يدعون إلى الدنيا..."
ويعلم مما مر أن الدنيا في حقيقتها مانع أمام الوصول إلى الله وهي مكان البعد والمطرودية والهجران، وأن على السالك أن ينظر إليها بهذا النظر فيصدف عنها ويعرض. وقد طرح الإسلام برنامجاً بهذا الخصوص هو برنامج الشريعة التي تمكن الإنسان من تحقيق هذا الإعراض والزهد. ومن أهم عناصر هذا البرنامج أن يأخذ منها مقدار الكفاف ويعرض عنها بقلبه فلا يشغل بهمومها كما قال أمير المؤمنين عليه السلام:
"ووصف [رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] لكم الدنيا وانقطاعها، وزوالها وانتقالها.. فغضوا عنكم -عباد الله- غمومها وأشغالها، لما قد أيقنتم به من فراقها وتصرف حالاتها فاحذروها حذر الشفيق الناصح والمجدّ الكادح" (نهج البلاغة).
* في الإشارة إلى خطورة حب الدنيا
يقول الإمام الخميني قدس سره:
"فليعلم أن القلب بحسب فطرته وجبلته إذا تعلق بشيء وأحبه يكون ذاك المحبوب قبلة لتوجّهه...".
إن الله تعالى قد فطر خلقه على أساس حب الكمال والانجذاب نحوه والتعلّق به. وهذا الحب هو أساس كل نشاط وبهجة، وسبب كل عمل وحركة. وعندما يحب الإنسان شيئاً يتجه نحوه. فإذا وصل هذا الحب إلى درجة عالية وغلب عندها كل تعلق آخر، فإنه يأخذ بمجامع القلب، وينسي صاحبه كل محبوب ويجعل حياته منصرفة إلى هذا المطلوب.
وقد ورد في الأحاديث: "إن حب الشيء يعمي ويصم".
فإذا كان المحبوب هو الله تعالى، وتمكن هذا الحب في القلب فإنه يجعل صاحبه منقطعاً إليه وينسيه ما عداه. يقول الإمام قدس سره:
"فأهل المعارف وأرباب الجذبة الإلهية إذا كانت قلوبهم قوية وصاروا متمكنين في الجذبة والحب يشاهدون في كل مرآةٍ جمال المحبوب، وفي كل موجود كمال المطلوب، ويقولون: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله فيه ومعه".
والمشكلة هي أن هذه الفطرة التي كانت لأجل ربط الإنسان بالمحبوب الأول والمطلوب الأكمل خرجت عن دورها. وبدلاً من أن يلبي صاحبها نداءها الأزلي إذ به يرى الكمال في هذه الدنيا الفانية والملذات الزايلة. وبدلاً من أن تقوده هذه الفطرة إلى الكمال المطلق والجمال اللامحدود بحسب أصل وجودها، فإنه لا يرى من الكمال الأزلي، إلا كمالاً محدوداً فانياً يجعله قبلة أعماله في الليل والنهار.
وعلى أثر هذا التوهم يخرج الإنسان من مسيرة الإنسانية بخروجه عن عبادة الحق والتوجه إليه، ويصبح كل همّه نيل الشهوات الرخيصة والملذات المحدودة.
يقول الإمام قدس سره:
"وأما الذين يكون في قلوبهم حب المال والرياسة والشرف فأولئك يشاهدون مطلوبهم في المنام أيضاً، ويتفكرون في محبوبهم في يقظتهم. وما داموا يشتغلون بالدنيا فهم يعتنقون محبوبهم. فإذا حان وقت الصلاة وحصل للقلب فراغ فإنه يتعلق بمحبوبه فوراً.. فكأنما تكبيرة الإحرام هي مفتاح دكان أو رافعة للحجاب بينه وبين محبوبه، فينتبه وقد سلّم في صلاته وما توجه إليها أصلاً...".
ويُعلم مما مر عدة أمور:
أولاً: أن الله تعالى قد فطرنا على أساس حب الكمال المطلق.
ثانياً: أن هذا الحب يجعل الإنسان منجذباً إلى المحبوب دائم التوجه إليه.
ثالثاً: أن الكثيرين يتوهمون أن محبوبهم هو الدنيا.
رابعاً: وعلى أساس هذا التوهم فإنهم يجعلونها قبلة آمالهم.
خامساً: وهذا الحب هو الذي يمنع من حضور القلب وتوجّهه إلى الله في الصلاة.
*العلاج:
يقول الإمام قدس سره:
"وبالجملة فإن قلوبنا لما كانت مختلطة بحب الدنيا، وليس لها مقصد ولا مقصود غير تعميرها. فلا محالة أن هذا الحب مانع من فراغ القلب وحضوره في ذلك المحضر القدسي، وعلاج هذا المرض المهلك والفساد المبيد هو العلم والعمل النافعان".
فالخطوة الأولى هي العلم والمعرفة، ويذكر الإمام أنه قد عالج هذا الموضوع في "شرح الأربعون حديثاً". وإن أفضل طريق لتحصيل العلم النافع هو بالرجوع إلى سيرة وكلمات الأئمة المعصومين (عليهم السلام) الذين يشاهدون الدنيا على حقيقتها وهم أفضل من يبين لنا هذه الحقيقة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: "حب الدنيا رأس كل خطيئة".
وقال عليه السلام: "الدنيا بمنزلة صورة رأسها الكبر وعينها الحرص وأذنها الطمع ولسانها الرياء ويدها الشهوة ورجلها العجب وقلبها الغفلة وكونها الفناء، وحاصلها الزوال. فمن أحبها أورثته الكبر ومن استحسنها أورثته الحرص، ومن طلبها أوردته إلى الطمع، ومن مدحها ألبسته الرياء، ومن أرادها مكنته من العجب، ومن اطمأن إليها أولته الغفلة، ومن أعجبه متاعها أفنته، ومن جمعها وبخل بها ردته إلى مستقرها وهي النار".
يقول الإمام قدس سره:
"والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تسعها هذه الأوراق، فإذا علم أن حب الدنيا هو مبدأ ومنشأ جميع المفاسد فعلى الإنسان العاقل المعتني بسعادته أن يخلع هذه الشجرة بجذورها عن القلب".
ونحن نذكر في هذا المجال لمن يريد التبصر العلمي بحقيقة الدنيا أن يرجع إلى نهج البلاغة لمولى الموحدين عليه السلام. فإن فيه من الكلام حول الدنيا ما يغني اللبيب ويقنع البصير.
أما العلاج العملي الذي يطرحه الإمام فهو بالطريقة السلبية أولاً، وذلك بالمعاملة بالضد. فإذا كان قلبه متعلّقاً بالمال عليه أن ينفق ويتصدق. وإذا كان يحب الرئاسة والجاه فليبتعد عن موجباتها وليعمل بالخلاف. فإن من شأن هذه المجاهدة خروج حب الدنيا تدريجياً من القلب بسبب ما سيعاينه المجاهد من لذة الإنس بالحق. وقد شوهد هذا الأمر كثيراً عند أصحاب المجاهدات القلبية الذين نالوا من الأنس والبهجة بالحق ما أنساهم هذه الدنيا الغرور وأخرج حبها من قلوبهم كلياً.
وينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة للغاية، وهي أن البرنامج الذي يطرحه الإسلام في هذه المجاهدة يقوم على أساس الالتزام التام بالأحكام الشرعية، ولا يجوز للمجاهد وتحت حجة العمل للتخلص من حب الدنيا أن يبتدع من نفسه برنامجاً أو منهجاً كما هو حال أكثر المتصوفين ابتدعوا في الدين ما جعلهم يصلون في نهاية المطاف إلى الشيطان الرجيم.
إن الشريعة الإسلامية كافية في هذا المجال بكل تشريعاتها وحدودها وليس على المجاهد إلا أن يمعن النظر في هذه الأحكام حتى يتبين له هذا المنهج الإلهي الواضح بإذن الله تعالى.



















