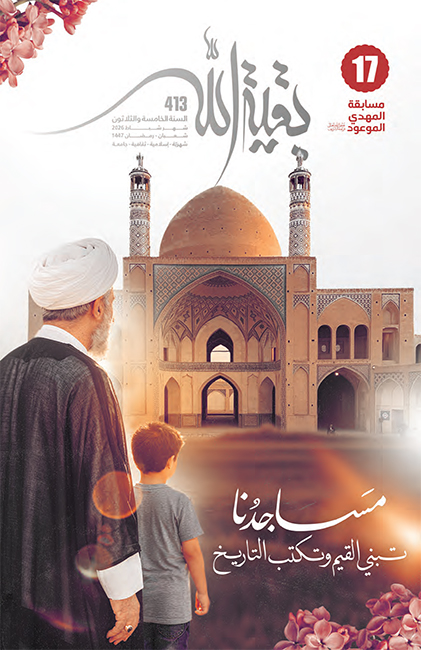أخلاقنا | لا تجعل في قلبك غلّاً (2)*

السيّد الشهيد عبد الحسين دستغيب قدس سره
بعد معرفة أضرار الحقد والبغض، يصبح من الضروريّ التوجّه إلى علاج مظاهره وصوره، بالإضافة إلى سبل الوقاية منه وتفادي آثاره.
• علاج النفور من التديّن
ينبغي أن يعرف من يستشعر طغيان نفسه على الدين وعلى أوامر الله، أنّ الله خالق الكون، ويعلم أنّه هو وعلاقاته وكلّ ما في عالم الوجود من الله تعالى، ثمّ يتأمّل في بناء جسمه بدقّة أيضاً ويلاحظ أجزاءه وأعضاءه وقواه الإدراكيّة، ويتأمّل في النِّعم الجزئيّة المتواصلة التي منَّ الله بها عليه ويمنّ، حتّى يعلم علم اليقين أنّها لا تُحصى.
فليتأمّل، مثلاً، في لقمة الخبز التي يأكلها كلّ يوم، ويلاحظ الأسباب التي لا تُحصى التي سخّرها ربّ العالمين جلّت قدرته حتّى يحصل على هذه اللقمة.
وليتأمّل أيضاً في الأسباب التي سخّرها الله تعالى للهضم، لتصبح هذه اللقمة جزءاً من البدن وموجبة لتقويته، مثل حركة الفكّ واللعاب والجهاز الهضميّ.
• حبّ المنعم فطريّ
بعد هذا اليقين، سيوفّق لحبّ ربّ العالمين؛ لأنّ حبّ المنعم فطريّ للإنسان. ولهذا، تكرّر في القرآن الكريم الأمر بذكر نِعم الله التي لا تُحصى؛ فإنّ من آثار هذا التذكّر، ترك الطغيان والتمرّد على أوامر الله. لذلك، يوفّق الإنسان لنيل نعمة الخشوع والخضوع، أيّ الحبّ والصداقة والتذلّل لله تعالى: ﴿فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الأعراف: 69)؛ بما أنّ تذكّر النِّعم وشكرها سبب للعلاقة باللّه وحبّه وتحقّق العبوديّة، فإنّ ذلك سبب زيادة النعمة والتنعّم، وهذا فقط هو سبيل الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة.
﴿فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾، (الأعراف: 74)؛ في هذه الآية الشريفة إشارة إلى أنّ نسيان نِعم الله يوجب أشدّ أنواع الفساد. أمّا سبب ذلك، فهو أنّ لكلّ جزء من أجزاء عالم الوجود كمالاً يجب أن يصل إليه تدريجيّاً، وفساده هو عدم وصوله إلى كماله المناسب له، أو سلبه منه إذا كان قد وصل إليه.
وبناءً عليه، إذا منع إنسان شيئاً من الوصول إلى كماله، فهو مفسد (مخرّب). وللإنسان الذي هو أشرف الموجودات، كمالٌ يجب أن يصل إليه، وهو معرفة ربّ العالمين والارتباط به والعبوديّة له، وهذا لا يحصل إلّا بزيادة ذكره وذكر نعمه الكثيرة.
• علاج رفض القضاء والقدر
من كان يغضب من القضاء التكوينيّ أو التكليفيّ الإلهيّين إذا خالفا هواه ورغبته، ولا يستسلم لحكم الله، يجب أن يلاحظ أموراً عدّة من أجل التخلّص من ذلك:
أوّلاً: الالتفات إلى علم الله وقدرته وعطفه عزّ وجلّ، والاعتقاد أنّ هذه الصفات موجودة في الله تعالى بلا نهاية ولا حدود.
ثانياً: الالتفات إلى جهله وغفلته، وأن يعلم أنّ حقائق الأمور وواقعها محجوبان عنه، بحيث إذا رأى أنّ وجود شيء مصلحة له، فيجب أن يُدخل في حسبانه أنّه قد يكون مخطئاً، ولعلّ ذلك واقعاً ليس مصلحة له، وكذلك العكس: ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 216).
بناءً على هذا، فتقدير الإنسان المصلحة لنفسه، أي أن يقول إنّ الأمر الفلانيّ مصلحة لي حتماً، هو خطأ وقبيح، بل يجب أن يكون أمام القضاء الإلهيّ كالمريض بين يدَي الطبيب الحاذق العطوف.
ثالثاً: الالتفات إلى أنّ كلّ المنغّصات التي تواجهه، وهي من وجهة نظره شرّ، كموت أحد أقاربه الذي يؤلمه ويحزنه كثيراً، فيها خيرٌ ما؛ إذ يجب أن يعلم أنّ الله ما قبض روح هذا الشخص إلّا لأنّ الموت كان خيراً له، وأفضل من استمرار حياته. فإذا كان عبداً مطيعاً، فقد نجا من هذه الدنيا ووصل إلى العالم الأعلى. وإذا كان طاغياً، فإنّ موته وضع حدّاً لطغيانه.
رابعاً: التذكّر أنّ أمام كلّ منغّص، ثمّة نعماً وافرة أعطاها الله تعالى له؛ فإذا افتقر، فليتذكّر نعمة العافية وعظمتها، وإذا مرض عضو منه، ليتذكّر عافية سائر أعضائه، والأهمّ من ذلك بقاء أصل الحياة.
والخلاصة: يجب أن يعلم أنّ كلّ نسبة من الألم والبلاء بالنسبة إلى النعم التي وهبها له الله تعالى، ليست شيئاً يُذكر.
نذكر كمثال هنا قصّة النبيّ يوسف عليه السلام. عندما التقى النبيّ يعقوب والنبيّ يوسف L، سأله يعقوب: يا بنيّ، حدّثني بما جرى عليك. قال: يا أبتِ، لا تسألني ماذا صنع بي إخوتي، بل سلني: ماذا صنع بي ربّي، وأين أوصلني.
وعندما عرفه إخوته وكانوا يجلسون معه صباحاً ومساءً إلى المائدة، كان الخجل يسيطر عليهم، فطلبوا منه أن يعفيهم من الحضور.
قال لهم: أنتم سبب عزّتي ورفعتي، لأنّ المصريّين كانوا يعدّونني قبل مجيئكم غلاماً وصلت إلى السلطنة. وعندما جئتم، عرفوا أنّي لست غلاماً، بل ابن نبيّ ومن أولاد إبراهيم الخليل.
خامساً: الالتفات كيف أنّ الموت يهدّده في كلّ لحظة، وأنّه لن يبقى أثر من ملذّات الدنيا ولا من منغّصاتها.
سادساً: التأمّل بدقّة في أحوال الناس المعاصرين له أو الماضين من كلّ الطبقات من الأغنياء والأقوياء: هل يجد منهم شخصاً واحداً لم يواجه في حياته المنغّصات والمصائب؟ أم أنّه كلّما زادت الثروة والقوّة كانت المصائب والبلايا أكثر؟ ومن هذا التأمّل نفهم قاعدة كلّيّة هي أنّ حياة البشر في الدنيا مبنيّة على البلاء، بحيث إنّه من اللوازم الحتميّة لهذه الحياة، وأمّا الحياة «الطيّبة» التي ليس فيها أيّ أذى وألم، فهي فقط في الجنّة.
سابعاً: التأمّل في أحوال الأنبياء والأئمّة وعظماء الدين، ليعلم أنّ كلّ من كان في هذا المضمار أكثر قرباً، كان له من كأس البلاء النصيب الأوفى.
فليعلم الإنسان أنّ أقصى ما يدركه من الدنيا زائل، وأنّ خير العِبر في مواجهة البلاء هو ترك الحقد، وشكر النعمة، والرضى بقضاء الله.
*مقتبس من كتاب: القلب السليم، ج 2، ص 362- 368.