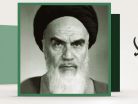أخلاقنا: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ

العلّامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي قدس سره
إنّ الإسلام يبني أساسه على اتّباع الحقّ وابتغاء الأجر والجزاء من الله سبحانه، وإنّما يتعلّق الغرض بالغايات والمقاصد الدنيويّة في المرتبة التالية وبالقصد الثاني. فعلى كلّ نفس إذا وردت مورد عمل أو صدرت، رقيب شهيد قائم بما كسبت، سواء شهده الناس أو لا، حمدوه أو لا، قدروا فيه على شيء أو لا. وقد بلغ من حسن تأثير التربية الإسلاميّة أنّ الناس كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعترفون عنده بجرائمهم وجناياتهم بالتوبة، ويذوقون مرّ الحدود التي تُقام عليهم، القتل فما دونه، ابتغاء رضوان الله وتطهيراً لأنفسهم من قذارة الذنوب ودرن السيّئات. وبالتأمّل في هذه النوادر الواقعة، يمكن للباحث أن ينتقل إلى عجيب تأثير البيان الدينيّ في نفوس الناس، وتعويده لهم السماحة في ألذّ الأشياء وأعزّها عندهم، وهي الحياة وما في تلوها(1).
•علاج الفساد الناشئ عن الأفعال
الفعل المخالف للحقّ، كالمعاصي وأقسام التهوّسات الإنسانيّة، ومن هذا القبيل أقسام الإغواء والوساوس، يلقّن الإنسان، وخاصّة العاميّ الساذج، الأفكار الفاسدة، ويعدّ ذهنه لدبيب الشبهات وتسرّب الآراء الباطلة فيه، وتختلف إذ ذاك الأفهام وتتخلّف عن اتّباع الحقّ. وقد كفى مؤونة هذا الإسلام، حيث أمر المجتمع بإقامة الدعوة الدينيّة دائماً أوّلاً، وكلّف المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثانياً، وأمر بهجرة أرباب الزيغ والشبهات ثالثاً.
قال تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ (آل عمران: 104). فالدعوة إلى الخير تستثبت الاعتقاد الحقّ وتقرّه في القلوب بالتلقين والتذكير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنعان من ظهور الموانع من رسوخ الاعتقادات الحقّة في النفوس، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ (الأنعام: 68 - 70). فالله تعالى ينهى عن المشاركة في الحديث الذي فيه خوض في شيء من المعارف الإلهيّة والحقائق الدينيّة بشبهة أو اعتراض أو استهزاء، ولو بنحو الاستلزام أو التلويح، ويذكر أنّ ذلك من فقدان الإنسان أمر الجدّ في معارفه، وأخذه بالهزل واللعب واللهو، وأنّ منشأه الاغترار بالحياة الدنيا، وأنّ علاجه التربية الصالحة والتذكير بمقامه تعالى(2).
•انعكاس العمل على صاحبه
مَن ظلم يتيماً في ماله، فإنّ ظلمه سيعود إلى الأيتام من أعقابه، وهذا من الحقائق العجيبة القرآنيّة، وهو من فروع ما يظهر من كلامه تعالى، أنّ بين الأعمال الحسنة والسيّئة وبين الحوادث الخارجيّة ارتباطاً.
الناس يسلّمون أنّ الإنسان إنّما يجني ثمر عمله، وأنّ المحسن الخيّر من الناس يسعد في حياته، والظلوم الشرّير لا يلبث دون أن يذوق وبال عمله. وفي القرآن الكريم آيات تدلّ على ذلك بإطلاقها، كقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا﴾ (السجدة: 46)، وقوله: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8)، وكذا قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (يوسف: 90)، وقوله: ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ (الحج: 9)، وقوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (الشورى: 30)، إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أنّ الخير والشرّ من العمل له نوع انعكاس وارتداد إلى عامله في الدنيا.
•انعكاس عمل الإنسان على ذرّيّته
والسابق إلى أذهاننا المأنوسة بالأفكار الدائرة في المجتمع من هذه الآيات، أنّ هذا الانعكاس إنّما هو من عمل الانسان إلى نفسه. إلّا أنّ هناك آيات دالّة على أنّ الأمر أوسع من ذلك، وأنّ عمل الإنسان خيراً أو شرّاً ربّما عاد إليه في ذرّيّته وأعقابه، فقد قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ (الكهف: 82)، فظاهر الآية أنّ لصلاح أبيهما دخلاً فيما أراده الله رحمة بهما، وقال تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ﴾ (النساء: 9). وعلى هذا، فأمر انعكاس العمل أوسع وأعمّ، والنعمة أو المصيبة ربّما تحلّان بالإنسان بما كسبت يد شخصه أو أيدي آبائه. والتدبّر في كلامه تعالى يهدي إلى حقيقة السبب في ذلك، ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ (البقرة: 186)، دلالة على أنّ جميع ما يحلّ بالإنسان من جانبه تعالى إنما هو لمسألة سألها ربّه، وأنّ ما مهّده من مقدّمة وداخَلَه من الأسباب سؤال منه لما ينتهي إليه من الحوادث والمسبّبات، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (الرحمن: 29)، وقال تعالى: ﴿وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا﴾ (إبراهيم: 34)، ولم يقل وإن تعدّوه لا تحصوه؛ لأنّ فيما سألوه ما ليس بنعمة، والمقام مقام الامتنان بالنعم، واللوم على كفرها، ولذا ذكر بعض ما سألوه وهو النعمة.
•وجهة الخير
إنّ ما يفعله الإنسان لنفسه ويوقعه على غيره من خير أو شرّ، يرتضيه لمن أوقع عليه وهو إنسان مثله، فليس إلّا أنّه يرتضيه لنفسه ويسأله لشخصه، فليس هناك إلّا الإنسانيّة. ومن هنا يتّضح للإنسان أنّه إن أحسن لأحد فإنّما سأل الله ذلك الإحسان لنفسه، دعاءً مستجاباً وسؤالاً غير مردود، وإن أساء إلى أحد أو ظَلَمه فإنّما طلب ذلك لنفسه وارتضاه لها، وما يرتضيه لأولاد الناس ويتاماهم يرتضيه لأولاد نفسه ويسأله لهم من خير أو شرّ، وقد قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ﴾ (البقرة: 148)، فإنّ معناه: أن استبقوا الخيرات لتكون وجهتكم خيراً. والاشتراك في الدم ووحدة الرحم يجعل عمود النسب -وهو العترة- شيئاً واحداً، فأيّ حال عرضت لجانب من جوانب هذا الواحد، وأيّ نازلة نزلت في طرف من أطرافها، فإنّما عرضت ونزلت على متنه، وهو في حساب جميع الأطراف... فقد ظهر بهذا البيان أنّ ما يعامل به الإنسان غيره أو ذرّيّة غيره، فلا محيص من أن ينعكس على نفسه، أو ينقلب إلى ذرّيّته، إلّا أن يشاء الله. وإنّما استثنينا لأنّ في الوجود عوامل وجهات غير محصورة، لا يحيط بجميعها إحصاء الإنسان، ومن الممكن أن تجري هناك عوامل وأسباب لم نتنبّه لها، أو لم نطّلع عليها، توجب خلاف ذلك، كما يشير إليه بعض الإشارة قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ (الشورى: 30)(3).
1.الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، ج4، ص114.
2.(م.ن)، ج4، ص128 - 129.
3.(م.ن)، ج4، ص201 - 203.