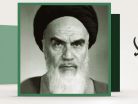نور روح الله: الإيمان.. حظّ القلب

اعلم أن الإيمان غير العلم والفهم؛ إذ هما حظ العقل وهو حظ القلب، ولا يمكن وصف الإنسان بأنه مؤمن بمجرد حصوله على العلم بالله وملائكته وأنبيائه ويوم القيامة، فقد وصف الله تبارك وتعالى إبليس بأنه كافر(1) رغم أنه كان على إحاطة علمية وإدراكية بهذه الأمور.
* المراد من الإيمان
واعلم، أن الإيمان بالمعارف الإلهية وأُصول العقائد الحقة لا يتحقق إلا بما يلي:
أن يفهم المرءُ أولاً تلك الحقائق بوسيلة التفكر والرياضات العقلية، والآيات والبينات والبراهين العقلية، وهذه المرحلة هي بمثابة مقدمة الإيمان. وبعد أن يستوفي العقل نصيبه منها، لا ينبغي أن يقنع بها، لذا يجب أن يشتغل السالك إلى الله بالرياضات القلبية لكي يوصل هذه الحقائق إلى القلب فينعقد عليها. وهنا تتمايز مراتب الإيمان. فمثلاً: التوكل على الله تعالى هو أحد فروع التوحيد والإيمان، لكن حقيقة التوحيد (في التوكل) مفقودة عندنا رغم ذلك. نحن جميعاً نعلم أن لا أحد يستطيع التصرف بشيء في مملكة الحق تعالى من غير الإذن القيومي، ولا يمكن أن تغلب إرادة أي مخلوق إرادته القويمة عزَّ وجلَّ ولكنا مع ذلك نطلب الحاجات من أهل الدنيا وأصحاب الثروة ونغفل عنه تعالى! والسر في ذلك هو أن حقيقة التوحيد لم تدخل قلوبنا.
* صفات المؤمنين:
يقول تبارك وتعالى في الآية الثانية من سورة الأنفال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ إلى أن يقول: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (الأنفال: 2 4). فهو تبارك وتعالى يصرح وعلى نحو الحصر بأن المؤمنين هم الذين يتحلَّون بهذه الصفات، أي أن غيرهم ليسوا بمؤمنين، ثم يختم هذا الوصف بتأكيد الأمر والتصريح بأن الذين تتوفر فيهم هذه الصفات هم وحدهم المؤمنون حقاً. وصفاتهم المذكورة في الآية قد لاحظتموها؛ وأنتم تدعون الإيمان، وقد أدركتم عقلياً جميع أركانه ولديكم دليلٌ عقلي أو وجدتم دليلاً لكل منها، فارجعوا إلى أنفسكم وتدبروا فيها ولاحظوا أي تلك الصفات موجودة في قلوبكم. تسمعون أو ترددون كل هذا الذكر لله تعالى ولكن أين "وجل القلوب" الذي يظهر على المؤمن عند ذكر الله؟ لا ريب في أن القلب الذي لم يدرك وجدانياً عظمة الحق تعالى وجلاله، ولم يتجلَّ فيه كبرياؤه تعالى وعلوُّه؛ لا يوجل من ذكره عز وجل.
إذاً، فالخاصية الأولى من علامات المؤمن مفقودة فينا، وهكذا حال الخاصية الثانية وهي زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات الكريمة على المؤمن؛ فكل هذه الآيات التدوينية والتكوينية(2) تُتلى وتُعرض علينا لكنها تزيد من احتجابنا بدلاً من زيادة إيماننا! فما أكثر ما نتلوه ونسمعه من آي القرآن الحكيم في أيام عمرنا دون أن يظهر منه في قلوبنا نور الإيمان. وأما الخصوصية الثالثة المذكورة في الآية، فنجدها في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾، وحقيقة التوكُّل هي تفويض المرء جميع أُموره إلى وكيله والثقة به في ذلك وقطع الرجاء من غيره. مع أننا جميعاً نعتبره عالماً بكل ذرات الكائنات وأنّ علمه محيطٌ بجميع الموجودات (بجميع شؤونها) وقدرته الكاملة نافذة في الأرضين والسموات، ورحمته عامةٌ شاملة لجميع الخلائق، وأنه منزه سبحانه عن النقائص كافة ومنها البخل، ولكن رغم علمنا هذا بأركان التوكل وفقداننا لأيِّ شك (نظري) فيها، فإننا لا نرى أثراً للتوكل في أنفسنا، إذ إننا نثق ونطمع بما في أيدي الخلق أكثر من ثقتنا وطمعنا بما عند الخالق جلّ وعلا ونطلب حاجاتنا من المخلوق الضعيف، ونمد أيدي الطمع إلى الأدنين، ونسعى باستمرار إلى جذب قلوب الناس رغم أننا نعلم أن الحق تعالى هو مقلّب القلوب. ولا علة لذلك سوى أن العلم غير الإيمان بها.
(1)كما في قوله تعالى عن إبليس لعنه الله ـ: (أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) (البقرة: 34).
(2)يُقصد بالآيات التدوينية، آيات القرآن الكريم، والآيات التكوينية، علامات عظمة الله في خلائقه وآفاق السماوات والأرض.