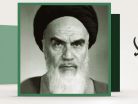مجتمع: شباب في دوامة الفيتامين "واو"

ايفا شعيتو
نُقل عن أحد الشباب قوله: "أتحيّن الفرصة لأترك هذا البلد وأسافر فأستقل الطائرة... ما الذي يجعل شاباً في مقتبل العمر يصرّح مثل هذا التصريح المتشائم؟ هناك رواية نقلتها جارتنا من على شرفتها إلى جارتنا الأخرى على الشرفة المقابلة، تحكي عن ابن جارتهم الثالثة الذي كان قد وجد عملاً بعد سنوات طويلة من البحث، في إحدى الشركات الخاصة، ولشدة فرحه بالعمل الجديد كما تقول جارتنا قرّر أن يخدم تلك الشركة بإخلاصٍ لا متناه. طبعاً أحد مصاديق الإخلاص، أن يتفجّر الإبداع، فكيف إذا كان ذلك الشاب متمتعاً بالإبداع أصلاً هبة من عند اللَّه تعالى فضلاً عن مهارات وطاقات كبيرة إضافة إلى الاختصاص المطلوب، فقد بدأ بتقديم الأفكار والمشاريع التطويرية والمبدعة للشركة المذكورة ولكن... اصطدم صاحبنا بسوسة سوداء كبيرة شكّلت جداراً بدأ يتجذّر بقوّة في تلك الشركة والظاهر في كلّ مثيلاتها، بل في كل البلد. سوسة من المعايير الجديدة "الجميلة" إلى حد البشاعة المطلقة، بدأت تنخر عظم الشركات والمؤسسات ولا بد أنها الآن في أقصى مراتب التخمة، هذا الأمر جعل التحضير لنعش إبداع ذلك الشاب أمراً أوتوماتيكياً ولا شعورياً، ابتداءً من التصادم ما بين معاييره التي تربّى عليها وبين تلك المعايير الدخيلة التي فرضتها تلك السوسة السوداء. فصاحبنا قد تربّى في بيته والمدرسة والجامعة على المعايير والقيم الإيجابية ولكنه لم يجد مع ذلك حضوراً لأي من معاييره الوطنية، القانونية، الدينية أو حتى العرفيّة الإيجابية في كومة تلك المعايير "الجديدة"، معايير السوسة.
قد تتساءلون الآن ما هي تلك المعايير "الجديدة"؟ وتجيب جارتنا نقلاً عن لسان الشاب أن أي إبداع أو عمل يتقدم به كان يسقط "سهواً" أو يُرفض وكان يرى الويلات أحياناً قبل أن يرى النور بسبب المعايير العمياء الجديدة للحكم على الأعمال. وكمعيار أوّل نُقل عن صاحبنا ما اصطلح عليه باسم "الفيتامين واو" أو الواسطة وهو معيار بات معروفاً ولكنه "تطْوَّر" اليوم ليصبح معناه "أن يعرّف عنك أحدهم" لأنك "مجهول" وبالتالي فإن الشركة لا تثق بك ولا بكفاءاتك التي سجلتها على طلب العمل بالخط العريض وهي بحاجة إلى شخص موثوق ليعرّف عنك حتى تستطيع دخول الشركة من بابها الواسع وهذا ما اعتمده صاحبنا للدخول إلى الشركة للأسف، إلا أنه اكتشف فيما بعد أن "الفيتامين واو" ضروري قبل وخلال وبعد كل عمل أو فكرة صغيرة يتقدم بهما. وقد يتّخذ "الفيتامين واو" أشكالاً متعدّدة، من التملق إلى المدير وصولاً إلى ممارسة الضغط بأحد "الكبار" من خارج الشركة إلى وإلى... والنتيجة تكون بأن تقبل الأفكار الباهتة التي يقدمّها أحد الموظفين "الغيورين" ويرمى الإبداع جانباً على حساب تطوّر الشركة ومصلحتها. ويُنظر إلى الفكرة المبدعة بعين "خبيرة" فاحصة تتوقّف لتنتقد أدنى التفاصيل فلا تغفر أدنى هفوة بينما يُنظر إلى الباهتة بعين "منبهرة"، مستحسنة و"إلى الأمام سيري" أيتها الشركة.
المهم... نكمل قصة صاحبنا فهو قد وجد نفسه مرغماً وبالقوة وفقاً لتلك المعايير أن يبدأ من الصفر في كل شيء. ويشرح المسألة بقوله نقلاً عن جارتنا : "إن كنت من الشباب الذين يستطيعون أن يتعلموا وينتجوا في شهر واحد ما لا يستطيع سواهم أن يتعلمه وينتجه في سنة. من حيث النوعية فإنك ستجد نفسك مرغماً رغم ذلك على الخضوع لمدة الـ"سنة" في التعلّم والإنتاج بسبب تلك المعايير التي باتت "قانوناً" سارياً وبالمختصر هذه جريمة بحق الإبداع والعقل وقتل بطيء لهما وحرب تحطيم للمعنويات". والمحور في هذه الإجراءات الخاطئة في المعاملة حسب تعبيره هو مدير معتاد على أن يسبّح الموظفون بحمده، وانتقاد العمل ملغيّ من قاموسه فالانتقاد وإن كان بنّاءً يضع صاحبه بحسب المعايير الجديدة في صفوف أعداء الشركة من الشركات المنافسة. هو نفسه ذاك المدير يفتقر إلى القدرات والكفاءات المفترض توفرها في من كان في منصبه وإن وجدت بالصدفة أخفاها ضيق أفقه الذي يتمتّع به نتيجة عدم متابعته للمستجدات في مجال عمله. فكم من مرة جلس صاحبنا الشاب أمام مديره يشرح ويشرح عن فكرة مشروع جديد تمثل خلاصة ما توصل إليه الباحثون والمدير يهزّ برأسه ويعلّق بكلمات تنمّ عن عدم فهمه للمطروح ولا مبالاته وفي النهاية يحكم بأن هكذا مشروع ليس من أولولايات الشركة ولا من سياساتها علماً أن كل عقلاء العصر قد أجمعوا على العكس! ويتحرّى صاحبنا عن الأمر عبر أحد المقربين إلى المدير ليطّلع على حقيقة الأمر فيفاجأ بأن المدير يعتقد بأنه شخصياً قد تعب كثيراً ولم يصل إلى منصبه بسهولة لذلك على كل موظف مهما كانت قدراته أن يجسد معاناة مديره وممنوع عليه القفزات النوعية لأن سير التطور "الطبيعي" هو ذاك الشبيه بسير المدير!
وتتوالى معايير الحكم على أعمال صاحبنا فمن الموظفين القدماء الذين دبّت فيهم الغيرة من الموظف الجديد خوفاً على "الكراسي" وصولاً إلى خضوع المدير لضغوطاتهم وضغوطات مجلس الإدارة الذي لأحدهم صلة وثيقة بأحد أعضائه ويعمد المدير كخلاصة إلى اعطاء عمل الشاب إلى أحد القدماء فهو لا يستطيع المجازفة بتوكيل تنفيذه إلى شاب جديد وطبعاً مع إلصاق اسم الموظف القديم على فكرة المشروع حتى! عجيب كيف لا يعرفون أن للمبدع كرسيه الذي ينقله معه أنّى ذهب. أخيراً يقف صاحبنا هذا، متسائلاً: طالما أن المعادلة هي هكذا فلماذا تمّ قبولي في الشركة من الأساس؟ ويجيب نفسه لا بد وأنه "الفيتامين واو" أو سياسة مقصودة أو غير مقصودة من الحرب النفسية وتحطيم المعنويات لجيل كامل، وطبعاً لا ننسى أن راتبه يخضع "للجزْر" وفقاً لكل تلك المعايير العوجاء. والنتيجة؟ سألت جارتنا جارتها. النتيجة أنه يقبع اليوم في المنزل. واقعاً لا أدري ما أقول بعد سماع هذه المأساة... ولكن صاحبنا ليس الوحيد الذي خضع لهذه المعايير ووصل إلى نفس هذا الوضع لأنه على ما يبدو، أن السوسة منتشرة على طول البلد لِتُدَفِّع شريحة الشباب وتحديداً المبدعون منهم ثمناً غالياً ويصلوا إلى إحدى نتائج ثلاث:
أولاها: السفر إلى خارج البلد.
ثانيها: أن يتيهوا في دوامة الفساد المستشري.
ثالثها: أن يكونوا بركاناً على استعداد للانفجار في أية لحظة تاركاً وراءه ثغرة كبيرة يتسلل منها أعداء البلد.
تركت الجارتين تتحدثان لأطرح على نفسي بعض الأسئلة. أين هي تلك السياسات التي تحتضن وتستثمر طاقات الشباب وخاصة طاقات المبدعين منهم؟ أين هي تلك السياسات التي تلغي مثل تلك المعايير القاتلة فتسمح بتطور مؤسسات البلد على أيدي المبدعين من شبابه الذين هم الركن الأساس في تطوير أي عمل وأي مؤسسة؟ وأين هي تلك السياسات التي تضع أسلوباً خاصاً في التعامل مع تلك الشريحة وخاصة المبدعين فيها كي نتجنّب قتل إبداعهم أو قمعه كحل؟ للأسف... كلها غير موجودة وهذه غصة ما بعدها غصة... فلتتنعّم بلاد الخارج بإبداع فلذات أكبادنا "ألف صحتين وهنا". ولننتظر النتائج المترتبة على غياب هكذا سياسات.