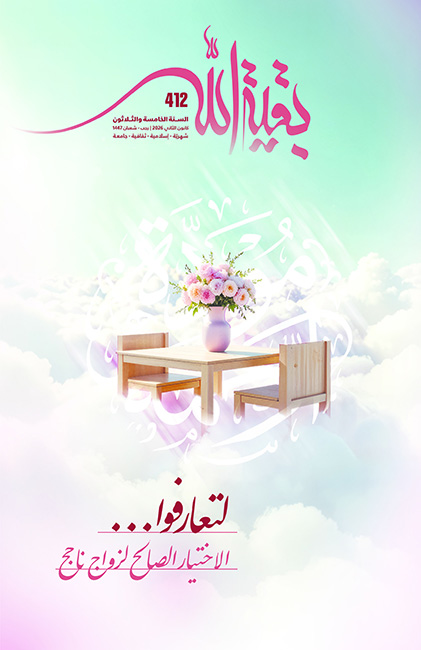بالهمّة يسمو العمل

الشيخ د. أكرم بركات
أمام الإنسان في مسيرته احتمالان لا ثالث لهما: إمّا الربح أو الخسارة. وحتّى لا يصل في مساره إلى الخسارة، فهو بحاجة إلى أن يتزوّد بعناصر أربعة بحسب سورة العصر، وهي: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحقّ، والتواصي بالصبر.
إذاً، لتجنّب الخسارة وتحقيق الأرباح، لا بُدّ -بالإضافة إلى الإيمان- من العمل الجادّ، لذا قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (فاطر: 10)؛ فالعمل الصالح هو رافعة الكلم الذي هو العقيدة.
* العمل الواعي
انطلاقاً من هذه المقدّمة، فالإنسان الذي يعي الهدف من حياته: ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الملك: 2)، يعمل على تحقيق مجموعة من الأمور:
أوّلاً: أن يُخرج نفسه من حالة الفراغ والخمول إلى العمل والجدّ حتّى لا يكون من النادمين يوم القيامة. فعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: «يُفتح للعبد يوم القيامة على كلّ يوم من أيّام عمره أربع وعشرون خزانة -عدد ساعات الليل والنهار- فخزانة يجدها مملوءة نوراً وسروراً، فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزّع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار، وهي الساعة التي أطاع فيها ربّه، ثمّ يفتح له خزانة أخرى، فيراها مظلمة منتنة مفزعة، فيناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل الجنّة لنغّص عليهم نعيمها، وهي الساعة التي عصى فيها ربّه، ثمّ يفتح له خزانة أخرى، فيراها فارغة ليس فيها ما يسرّه ولا ما يسوؤه وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنيا، فيناله من الغبن والأسف على فواتها حيث كان متمكّناً من أن يملأها حسنات ما لا يوصف، ومن هذا قوله تعالى: ذلك يوم التغابن»(1).
ثانياً: أن يبحث عن العمل الصالح ليعمله.
ثالثاً: أن يختار الأولى بين الأعمال ليقدّمه على غيره.
* عامل مساعد: الهمّة العالية
لتحقيق ذلك بأحسن صورة، فإنَّ الإنسان يحتاج إلى همَّة عالية، فبدونها لا يحقّق غاية وجوده. لذا، ربطت الأحاديث الشريفة الكثير من محاسن الأفعال والصفات والقيم النبيلة بالهمَّة العالية، ويتبيّن ذلك من خلال الأمور الآتية:
1. الفعل الجميل: إنَّ من يرَ فعلاً يتّسم بالجمال، سواء كان من خلال صنعة أو إدارة أو بناء أو كتاب أو لوحة أو أيّ شيء آخر، يعرف أنّ وراء ذلك العمل همَّة عالية استوجبت مدح أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «الفعل الجميل ينبئ عن علوّ الهمّة»(2).
2. الشجاعة: وهكذا حال الشجاعة التي هي من أنبل صفات الإنسان، ويربط الإمام عليّ عليه السلام بينها وبين الهمّة بقوله: «شجاعة الرجل على قدر همّته»(3).
3. الكرم: الكرم في حديث الإمام عليه السلام ناتج عن همَّة الإنسان العالية، إذ يقول عليه السلام : «الكرم نتيجة علوّ الهمّة»(4).
4. القناعة: إنّ من نتائج الهمّة العالية، التي تدفع الإنسان إلى العمل وإتقانه، قناعته بما وصل إليه بعد السعي بكلّ وُسعه، لذا، ورد عن الإمام عليّ عليه السلام : «من شرف الهمّة لزوم القناعة»(5)، وعنه عليه السلام : «الكفُّ عمّا في أيدي الناس عفّة وكبرُ همّة»(6).
* كيف تُصنع الهمّة؟
إذا كانت الهمّة هي الدافع لتحقيق هدف الإنسان في الحياة، ومنشأً أساسيّاً في تلك الكمالات، فحريّ به أن يبحث عمّا يولّد تلك الهمّة، ويرفعه من حالة الخمود والخمول إلى الجدّ في العمل.
وفي سياق الإجابة عن ذلك المحفّز للهمّة الذي يرفع الإنسان إلى مستوى الجدّ، تتجلّى معرفة قيمة العمل وأهميّته كأولى المراتب في بناء الهمّة؛ إذ ثمّة فرق شاسع بين شخص طُلب منه أن يسعى نحو جوهرة نفيسة على أن يمتلكها حينما يحوزها، وقد عرف قيمتها الغالية جدّاً، وبين شخص طُلب منه أن يسعى نحو تلك الجوهرة كحال صاحبه، إلّا أنّه لا يعرف أنّها جوهرة، بل يظنّها زجاجة؛ فكم من اختلاف كبير بين همَّة الأوّل نحو العمل وهمّة الآخر في السعي إليه؟!
من هنا، جاء الدين ليبيِّن أهميّة العمل الصالح في هذه الدنيا ومكانته وقيمته، ليبذل الإنسان همّته حتّى يصل إلى أعلى مراتبه؛ فالعمل الصالح هو رافعة العقيدة وغاية خلق الموت والحياة، كما تقدّم.
* أهمّ أركان العمل الصالح
للعمل الصالح ركنان أساسيّان، هما:
الأول: أن يكون لله تعالى؛ أي في طريقه عزّ وجل الذي يعني طريق الكمال المطلق. ومعنى ذلك أن يكون العمل في مسار تكامل الإنسان ورقيّه وتكامله. وكلّ عمل لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أي منقطع الآخر، فلا يستفيد الإنسان منه في الآخرة.
وفي هذا المسار، قد لا يكون التواضع مناسباً عند تحديد الغاية الأخرويّة التي يرجوها الإنسان من الله تعالى؛ إذ ينبغي له السعي للحصول على أعلى المراتب.
الثاني: أن يساهم في المشروع الإنسانيّ على الأرض المحقّق لخلافة الله تعالى، وهذا يتحقّق من خلال العمل على محورَين أساسيّين: تزكية النفس، وخدمة المجتمع.
وسورة العصر ببيانها أركان النجاة الأربعة، تدور حول هذين المحورَين، وإليهما أرشد الإمام الصادق عليه السلام في حديثه: «خصلتان من كانتا فيه وإلّا فأعزب ثمّ أعزب ثمّ أعزب: الصلاة في مواقيتها والمحافظة عليها، والمواساة»(7).
* في خدمة المجتمع
بتزكية النفس يسير الإنسان في درب خلافة الله تعالى، وكذا في خدمة المجتمع. من هنا، فإنَّ العمل النافع للمجتمع، الذي ينطلق من النيّة المخلصة، له ثواب عظيم وأجر جزيل، ويكفي ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «الخلق كلّهم عيال الله، فأحبُّهم إلى الله عزّ وجلّ أنفعهم لعياله»(8). ومن خلال هذا الكلام نفهم سرّ تقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليد العامل الذي بعمله كان يحيي الأرض، ويكدّ على عياله، وينفع مجتمعه.
إنّ من يعرف قيمة سلوك طريق خدمة المجتمع، تعلو همّته ويشتدّ اندفاعه؛ فالطالب حين يقصد من درسه عيش الكرامة ونفع المجتمع، ويعرف أنّ في ذلك مرضاة الله، تعلو همّته نحو الدرس. والأستاذ حينما يتعرّف على حبّ الله تعالى للمعلّمين العلم النافع، تعلو همّته في تربية الجيل نفعاً وصلاحاً. والصانع حينما يتعرّف على حبّ الله تعالى لعمله تعلو همّته في صنعته، وحينما يتقنه يشمله وصف رسول الله: «إن الله تعالى يحبّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقنه»(9). والموظّف حينما يعرف أنّ عمله فيه رضى الله، تعلو همّته في أداء وظيفته على أحسن حال. والتاجر حينما يعرف أنّ من خلال تجارته الشريفة ينال الرضى الإلهيّ والبركة الربّانيّة، تعلو همّته في تجارته. والأبوان اللذان يقصدان وجه الله من جهدهما في تربية الأولاد، ويعرفان مدى حبِّ الله تعالى لعملهما، تعلو همّتهما في ذلك. والمجاهد في سبيل الله حينما يقصد بجهاده وجه الله، ويعرف مكانة المجاهد عنده، تعلو همّته في عمله الجهاديّ.
والسالك في عبادة الله حينما يشعر بلذّة القرب في عبادته تعلو همّته، فيدعو بدعاء الإمام زين العابدين عليه السلام : «يا من آنس العارفين بطول مناجاته، وألبس الخائفين ثوب موالاته، متى فرح من قصدت سواك همّته؟ ومتى استراح من أرادت غيرك عزيمته؟»(10).
(1) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 7، ص 262.
(2) ميزان الحكمة، العلامة الريشهري، ج 4، ص 347.
(3) المرجع نفسه، ج 2، ص 1412.
(4) المرجع نفسه، ص 2684.
(5) ميزان الحكمة، مصدر سابق، ج3، ص 2637.
(6) المرجع نفسه، ج 4، ص 3470.
(7) الخصال، الشيخ الصدوق، ص 47.
(8) وسائل الشيعة، الحرّ العامليّ، ج 11، ص 566.
(9) ميزان الحكمة، مرجع سابق، ج 3، ص 2132.
(10) الصحيفة السجّادية، ص 441.