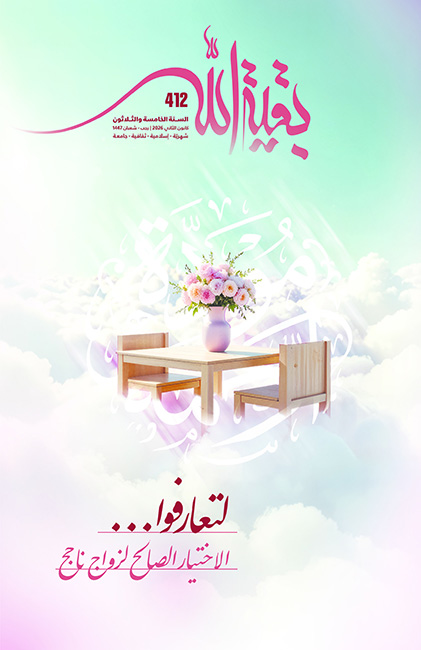كشكول الأدب
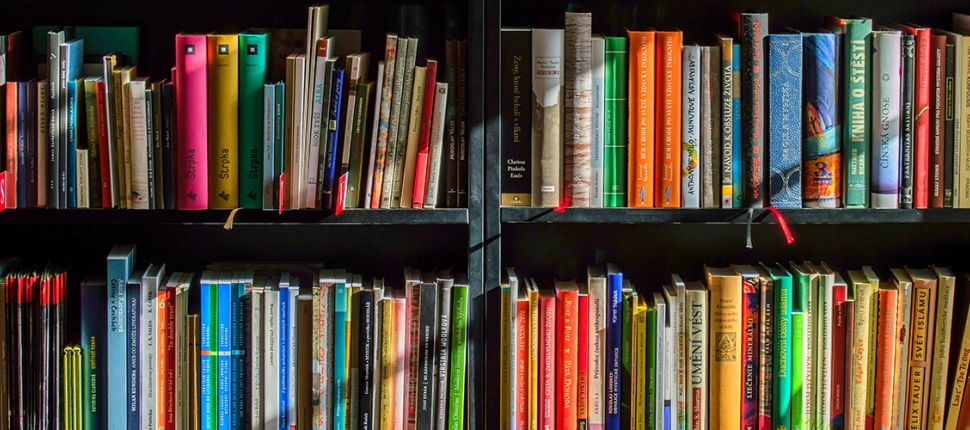
د. علي ضاهر جعفر
* من فقه اللغة
ممّا اختُصَّتْ به لغةُ العرب قَلْبُهُمُ الحروفَ عن جهاتِها، ليكون الثّاني أخفَّ من الأوَّل، نحو قولهم: «ميعاد» ولم يقولوا «مِوْعاد»، وهما من الوعد، إلّا أنَّ اللّفظ الثّاني أخفّ.
ومن ذلك تركهم الجمعَ بينَ السّاكنَيْن، وقد تجتمع في لغة العجم ثلاث سواكن. ومنه قولهم: «يا حارِ» ميلاً إلى التّخفيف بدلاً من «يا حارث».
ومنه اختلاسُهُم الحركاتِ في مثلِ قولِهم: «فاليومَ أشرَبْ غيرَ مُستَحقِبٍ».
ومنهُ الإدغامُ، وتخفيفُ الكلمة بالحذف، نحو: «لم يَكُ»، و«لَمْ أُبَلْ»، ومن ذلك إضمارهم الأفعال، نحو: «امرؤٌ أتقى الله»، و «أمرَ مبكياتِك، لا أمرَ مُضحِكاتِك»(1).
* عاميّ أصله فصيح
نقز - النَّقزة: وقالوا نَقَزَ يَنقُزُ نَقزاً ونَقزَةً إذا فاجأه ذعر فوثب وارتعد. وفي اللّغة: نَقَزَ يَنْقزُ نِقازاً ونَقزاً وَنَقزاناً = وثبَ صُعُداً. وهكذا تفعل المفاجأة بِالمَذعور. ونقز وقفز من وادٍ واحد(2).
* من البلاغة
الاستعارات الجاهزة: عبارة شعريّة اصطلاحيّة تُستخدم بدلاً من اسم شخص أو شيء أو بالإضافة إليه.
والعبارة ذات أصل إيرلنديّ، وهي تشير إلى ضرب من القول الجاهز أو المألوف يتميّز بأنّه تركيبة استعاريّة مزوّقة، فيُقال عن الزّورق إنّه مسافر الأمواج، وعن الظّلام إنّه خوذة اللّيل، وعن المحيط إنّه مسار الحوت أو طريقه، وهكذا(3).
* أمثال سائرة
«بَعدَ اللُّتَيّا والّتي»: هما الدّاهيتان الكبيرة والصّغيرة، وكنّى عن الكبيرة بلفظ التّصغير تشبيهاً بالحيّة، فإنّها إذا كثر سمُّها صغرت، لأنَّ السُّمَّ يأكل جسدها، وقيل: الأصل أنَّ رجلاً مِن جَديس تزوَّج امرأة قصيرة، فقاسى منها الشّدائد، وكان يعبّر عنها بالتّصغير، فتزوّج امرأة طويلة، فقاسى منها ضعف ما قاسى من الصّغيرة، فطلّقها، وقال: بعد اللُّتَيّا والّتي لا أتزوّج أبداً، فجرى ذلك على الدّاهية، وقيل: إنَّ العرب تُصغّر الشّيء العظيم، كالدُّهَيْم واللُّهَيْم، وذلك منهم رَمْز(4).
* رموز
الأربعون: هو العدد الّذي يرمز إلى مجموعة من المعاني الإيجابيّة، وذكر له بعضهم دلالات عرفانيّة استفاد منها الشّعراء والأدباء في نتاجهم. فقد ورد الحثّ على حفظ أربعين حديثاً، وفي هذا ألّف الإمام الخمينيّ قدس سره وقبله الشّيخ البهائيّ، وسواهما من العلماء، كتباً سمّوها «الأربعون حديثاً».
كما أنّ غيبة النبيّ موسى عليه السلام استمرّت أربعين ليلة: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ (الأعراف: 142). كما أنَّ الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأربعين من عمره الشّريف، إلى غيرها من دلالات هذا العدد ومعانيه الرّمزيّة.
وقد استفاد الشّعراء في هذا المضمار من هذا الرّمز؛ فسمّى أحدهم ديوانه «الأربعون ظلّاً»، كما استفاد آخرون من فكرة الغياب أربعين يوماً وليلة، إلى غيرها من الأمثلة الّتي وظّفوا فيها هذا الرّمز واستثمروه في إسباغ المزيد من الدّلالة والإيحاء والشّعريّة على نصوصهم وقصائدهم.
1. الصّاحبيّ في فقه اللّغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسين أحمد بن فارس، ص 21.
2. قاموس ردّ العاميِّ إلى الفصيح، الشّيخ أحمد رضا، ص 561.
3. معجم المصطلحات الأدبيّة، إبراهيم فتحي، ص 19.
4. مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمّد الميدانيّ، ج 1، ص 133- 134.